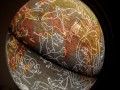الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
عن «الفكرة القومية»... العرب نموذجاً

عريب الرنتاوي
بقلم: عريب الرنتاوي
للوهلة الأولى، بدت مبادرة «راديو سوا» لفتح ملف عن مصائر ومآلات «الفكرة القومية العربية» خارجة عن سياق الأحداث والتطورات في المنطقة، بيد أن الأسئلة التي طرحها مُعدّو البرنامج أعادت للمسألة قيد البحث «راهنيتها»، ولم يعد الحديث بشأنها عزفاً منفرداً أو تحليقاً خارج السرب.
وأبدأ مقالتي اليوم، كما بدأت حديثي للراديو قبل أيام، بالتمييز بين مدارس ثلاث راهنة في النظر لهذه المسألة:
الأولى؛ ويمكن تسميتها بـ»التقليدية»، وتنتمي إلى مرحلة صعود الفكرة وانتشارها، في خمسينيات القرن الفائت وستيناته، حين أمكن لتيارات فكرية ـ سياسية رئيسة ثلاثة، أن تجسد الفكرة في أحزاب عريضة، وأن تنتقل بها إلى قمة هرم السلطة في عدد من الدول العربية.
وسنرى أحزاباً وتيارات كالناصرية والبعثية و»القوميين العرب» تملأ الساحات والميادين، وتتولى مقاليد الحكم في كل من مصر وسورية والعراق وليبيا والجزائر واليمن الجنوبي، مدعومة بتأييد ملايين المواطنين في دول عربية عديدة، قبل أن تبدأ هذه الفكرة و»تياراتها» بالتراجع والانحسار، وتحديداً في ضوء نتائج الهزيمة المُذلّة في حرب يونيو عام 1967، وما تلاها من أحداث وتطورات في الدول المذكورة، والتي ترتبت على، وأفضت إلى، فشل الدولة العربية الحديثة، في القيام بوظائفها، وتفشي نظم الفساد والاستبداد و»الركود»، مع كل ما صاحبها من صراعات وتصفيات داخلية، وحروب وصراعات عربية بينية.
الثانية؛ ويمكن وصفها بـ»الخليجية»، وترتبط بالصراع المحتدم بين معسكرين عربيين ـ إقليميين، واحد بقيادة إيران والثاني بقيادة المملكة العربية السعودية، وهو صراع اتخذ ويتخذ أساساً طابعاً مذهبياً ـ دينياً، للتغطية على جوهره الجيوسياسي، وإن كان فتح الباب أمام نشأة مدرسة «قومية عربية» من قبل أطراف لطالما قاومت المدرسة الأولى وناصبتها العداء، ولم تظهر يوماً شغفاً أو تعلقاً بفكرة «القومية العربية»، بل ونظرت إليها بكثير من الشك والريبة، بوصفها تتصادم مع فكرة «الأممية الإسلامية» بمدرستيها «الإخوانية» و»السلفية».
مبرر نشأة هذه المدرسة هو حشد «العرب» في مواجهة «الفرس»، توازياً مع فكرة «القوس السنّي» في مواجهة «الهلال الشيعي»... وإذا كانت القاهرة ودمشق وبغداد قد مثّلت «حواضن» المدرسة الأولى، فإن الرياض وأبوظبي وبدرجة أقل، بعض المثقفين والسياسيين اللبنانيين، قد رفعوا لواء هذه المدرسة، وتولوا مهمة التنظير لها.
الثالثة؛ وهي المدرسة الأقل حضوراً (حتى الآن) على الساحة السياسية والفكرية العربية، ويمكن وصفها بالمدرسة الديمقراطية ـ الحداثية في الفكر القومي، وتسعى في استيعاب دروس فشل المدرسة الأولى، وتبدي أعمق المخاوف من «أجندة» المدرسة الثانية، وتجادل في وجوب انفتاح المدرسة القومية على الأقليات القومية والإثنية في مواجهة مفهوم «المركزية العربية» الذي ميّز خطاب المدرسة الأولى، واستلهام قيم الحرية والتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعيد الاعتبار لفكرة «المصلحة المشتركة» ومفهوم «التدرج» في استعادة الرابطة القومية وتعميقها، على حساب «الشعاراتية الزائفة»، في استلهام غير مباشر ـ ربما ـ لتجربة الاتحاد الأوروبي وبعض التكتلات الاقتصادية والسياسية الدولية.
وإذا كان صوت هذه المدرسة قد ارتفع عالياً بعد هزيمة حزيران 1967، إلا أن تطورات عديدة، ليست هذه المقالة مجالاً للخوض فيها، أبقت هذه المدرسة وممثليها، على «هامش» الحياة السياسية والفكرية العربية.
شيء من التاريخ
لم تكن نشأة الفكرة القومية في مختتم القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ناجمة عن تطور ملموس لرأسمالية صناعية عربية، أو نتيجة لتنامي حاجات «السوق» وقوانينه ومتطلباته، كما هو الحال في نشأة القوميات الأوروبية قبل مئتين أو ثلاثمائة عام.
النشأة الحقيقية للقومية العربية، فكرة وحركة، ارتبط أساساً بنضال الشعوب ضد الغزو الكولونيالي للمنطقة، ومحاولات دول إمبريالية تقاسم النفوذ فيها، وبخاصة في ضوء نتائج الحرب العالمية الأولى، وتعزز نفوذ هذه الفكرة في مرحلة «تصفية الاستعمار» وفي سياقات الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، باعتبارها حلقة من حلقات تصفية الاستعمار الكولونيالي للمنطقة العربية.
على أن الفشل المتراكم في حل القضية الفلسطينية، والهزائم المتكررة في الحروب العربية الإسرائيلية، فضلاً عن المآلات الكارثية للدولة الوطنية، دولة ما بعد الاستقلالات العربية، سيفضي لاحقاً إلى إصابة هذا التيار في مقتل، ودخوله في مرحلة الانهيارات المتلاحقة بعد ذلك.
هنا، وهنا بالذات، سيبدأ هذا التيار رحلة البحث عن «طوق نجاة» وسيعمل سياسيوه ومثقفوه على «تجديد» هذا التيار، وضخ دماء جديدة في عروقه، أقله لتخطي مرحلة «حروب الإلغاء» التي ميّزت علاقاته بالتيارات اليسارية والشيوعية ذات النفوذ الشعبي الواسع في تلك الأزمنة.
ويمكن القول إن سبعينيات القرن الفائت وثمانينياته، ستشهد على ولادة ظاهرتين اثنتين متلازمتين: الأولى، وتمثلت في اتجاه بعض التيارات القومية يساراً وتبنيها بعضاً من الأدبيات الماركسية ـ اللينينية في طبعاتها المختلفة من «ماوية» «وفيتنامية» و»غيفارية»... والثانية، وتجلت في التقارب الملحوظ بين تيارات قومية وأحزاب شيوعية عربية.
ويمكن النظر للعلاقات «المتميزة» بين الحزب الشيوعي اللبناني الذي خرج من عباءة «النص السوفياتي التقليدي» من جهة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، «الوريث الشرعي» لحركة القوميين العرب، والخارجة بدورها من «عباءة النص القومي التقليدي» إلى فضاءات «اليسار القومي» من جهة ثانية، بوصفها «ذروة سنام» هذا التلاقي بين التيارين الذي ميّز تلك الحقبة.
على أن «شهر العسل» بين هذين التيارين لن يستمر طويلا، فقد دخل إلى الساحة السياسية والفكرية العربية، لاعب جديد، سيكون له موقع الصدارة على المستوى الشعبي العربي، وهو التيار الإسلامي بطبعاته المختلفة، وتحديداً «الإخوانية» منها، وستظهر أحزاب وتيارات محسوبة على «الإسلام السياسي الشيعي».
وسيرفع تيار الإسلام السياسي بجناحيه السنيّ والشيعي، لواء «مقاومة إسرائيل»، «حماس» في فلسطين و»حزب الله» في لبنان، بعد أن ظلت هذه الراية حكراً على قوميين ويساريين ووطنيين عرب.
هنا، ومرة أخرى، سيدخل التيار القومي العربي مرحلة جديدة من «التكيّف» مع معطيات مرحلة جديدة، انتقلت فيها راية «الزعامة» للإسلام السياسي، وبوجود روافع إقليمية كبيرة لهذا التيار، تبدأ بإيران ولا تنتهي بتركيا ـ العدالة والتنمية، وسيتحول «المؤتمر الإسلامي ـ القومي» إلى رمز لهذا التحول في مواقف الحركة القومية التقليدية، وسيجرف إلى صفوفه كثيرا من قوى اليسار العربي، مسقطاً من حساباته، أن زعامة هذا المعسكر تنعقد أساساً لإيران، التي لا يجمعه بها رابط قومي أو مصالح عميقة مشتركة، تتخطى الالتزام اللفظي بمواجهة «الشيطانين الأكبر والأصغر»، فضلاً عن نظام حكمها، الذي يتعارض تماماً مع كل ما نشأ عليه اليسار والقوميون العرب.
في مرحلتي الصعود والهبوط، سيجد التيار القومي العربي التقليدي، نفسه في مواجهة مع دول خليجية، وإن بشروط مختلفة من حيث «توازنات القوى» وأشكال الصراع وأدواته.
في المرحلة الأولى، مرحلة صعود هذا التيار، جوبه بمقاومة من الدول المحافظة، التي انتظمت خلف الغرب والولايات المتحدة زمن الحرب الباردة وتحالفاتها، في مواجهة ما أسمي بـ»الخطر الشيوعي».. وفي المرحلة الثانية، ستجد بقايا هذا التيار نفسها في مواجهة غير متكافئة، مع هذه الدول، التي تنتظم مرة أخرى خلف الولايات المتحدة، ولكن في مواجهة ما يسمى اليوم بـ»الخطر الشيعي».
وإذا كانت المرحلة الأولى قد تميزت بموقف وموقع هجوميين لهذا التيار الذي استند إلى حواضن عربية قوية ودعم دولي من المعسكر الاشتراكي، فإن المرحلة الثانية، الحالية، ستتميز بانتقاله إلى موقف وموقع دفاعيين، في مواجهة «اللحظة الخليجية المهيمنة في العالم العربي».
أين من هنا؟
يجادل كثيرون بأن «فكرة القومية العربية» قد سقطت وانتهت، مستندين إلى إصابة التيار الذي يرفع لواءها بحالة من «هشاشة العظام»، وعلى اعتبار أن عصر ما بعد الحداثة، وثورات الاتصال والمعلومات والثورة الصناعية الرابعة، قد أزالت الحدود والأسوار بين مكونات «القرية الكونية الواحدة»، وأن العولمة والشركات العابرة للقارات، لم تعد تبقي مطرحاً للفكرة القومية ولا لمن يمثلها.
والحقيقة، أن ثمة شواهد كثيرة، تشي بأن هذه الفكرة، ما زالت كامنة وخبيئة في حراكات الشوارع العربية، وأن سنوات الفساد والاستبداد والركود، لم تنجح في انتزاعها من صدور وعقول وضمائر ملايين العرب في مختلف بلدانهم، بمن فيهم الأجيال الشابة... بدلالة «نظرية الأواني المستطرقة» التي فعلت فعلها إبّان ثورات «الربيع العربي»، وعودة القضية الفلسطينية إلى هتافات وشعارات الشوارع العربية المنتفضة في بيروت والخرطوم والجزائر وغيرها... وتنامي الإحساس بالهويات الوطنية الجامعة، بعد سنوات من «التشظي الهوياتي» في عدة بلدان عربية.
ثم، إن التبشير بـ»انمحاء» الهويات القومية في الغرب والدول الصناعية الكبرى، لا تؤيده كثير من الظواهر الدالة على عودة «الفكرة القومية» في الغرب، بدلالة هذا الصعود المقلق للحركات القومية واتخاذها في كثير من الأحيان طابعاً «عنصرياً فظاً»، وتفشي نفوذ اليمين الشعبوي والسياسات الانكفائية والحمائية، وبناء الجدران و»البريكست» والانسحابات المتكررة من معاهدات واتفاقات ومواثيق دولية، في مجالات الطاقة والبيئة والاقتصاد والمناخ وغيرها.
على أن الفكرة القومية العربية الجديدة (المدرسة الثالثة) ما زال ينقصها الكثير من التحديث والتجديد، لتصبح «أقل مركزية» وأكثر انفتاحاً» على الأقليات القومية من كرد وأشوريين وسريان وكلدان وأمازيغ وغيرها من مكونات وكيانات... ولتصبح أكثر تماهياً مع قيم الحداثة والعصر، قيم الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون ودولة المواطنة وسيادة القانون.
وإذا كان البعض قد راهن في العشرية الأولى للربيع العربي، على «وحدة العرب» عبر «البوابة الدينية»، الإسلامية بالطبع، بوصفها الرابط المُتبقي الذي يجمعهم، إلا أن أحداث هذه الحقبة بالذات، دللت وتدلل، على أن الدين، وبخلاف ما نشأت عليه أجيال عربية متعاقبة، يفرق ولا يوحد، ليس بدلالة الانقسامات الوطنية المترتبة على نظام حكم إسلامي بين مختلف المكونات والكيانات الوطنية فحسب، بل وبشهادة الانقسام السني ـ الشيعي، وما يستتبعه من انقسامات متناسلة كذاك الانقسام الدامي في البيئة الشيعية (العراق نموذجا) وفي البيئة السنية (اصطراع المدارس المذهبية والانقسام السلفي ـ الإخواني) وغير ذلك من الشواهد والنماذج.
لنخلص إلى القول: إن الفكرة القومية وإن ضعفت وضعفت معها الرابطة القومية، إلا أنها ثمة شواهد عديدة دالّة على بقائها ووجودها... وأن هذه الفكرة لكي تستعيد ألقها وحضورها، بحاجة للخروج بها من أسر المدرستين: التقليدية في طبعاتها الناصرية والبعثية، والخليجية المصممة على مقاس صراع المحاور الإقليمية، على أن تنفتح على قيم المدنية والمواطنة ومنظومات حقوق الإنسان والأقليات، وأن تجعل من الدولة المدنية ـ الديمقراطية ـ العلمانية، هدفاً لها، لا تساوم عليها، لأي سبب أو حجة وذريعة، فحكاية «لا صوت يعلو فوق المعركة» كانت سبباً رئيساً في فشل الفكرة في صعودها، وشعار «لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة»، يعيد إنتاج السيرة ذاتها في مرحلة هبوطها، وبشروط أسوأ وأكثر مأساوية من أي مرحلة مضت.
قد يهمك ايضا
«تمارين ذهنية» من وحي «الاستعصاء الفلسطيني»
«محكمة الجنايات»... الوجه الآخر للمسألة
GMT 15:33 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير
شعر عربي اخترته للقارئGMT 15:29 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير
شعر المتنبي - ٢GMT 15:18 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير
من شعر المتنبي - ١GMT 23:58 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير
شعر جميل للمعري وأبو البراء الدمشقي وغيرهماGMT 21:18 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير
أقوال بين المزح والجدوزيرة الاقتصاد تقرّ بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بنفس مستوها عالمياً
الرباط - المغرب اليوم
أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بنفس مستوى انخفاضها عالميا، وذلك منذ بداية سنة 2024. وقالت الاقتصاد والمالية، في جواب عن سؤال كتابي، قدمه النائب البرلماني عن ا�...المزيدسلاف فواخرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "سلمى"
تونس- المغرب اليوم
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها لفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى" من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي انتهت فعاليات دورته الـ35 والتي شهدت عرض العديد من الأفلام والأنشطة ال...المزيدإدارة الدفاع الوطني ُتحذر المغاربة من ثغرات خطيرة تهدد مستخدمي متصفح غوغل كروم
الرباط - المغرب اليوم
أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بالمملكة المغربية نشرة أمنية يوم 11 ديسمبر 2024 تحذر فيها من ثغرات أمنية خطيرة تؤثر على متصفح غوغل كروم. وصنفت هذه الثغرات على أنها ذات مستوى &qu...المزيدوزير الأوقاف المغربي يؤكد أن وزارته تعمل حالياً على ترجمة معانى القرآن الكريم إلى الأمازيغية
الرباط - المغرب اليوم
قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنه يتم حاليا الاعتكاف على ترجمة معانى القرآن الكريم إلى الأمازيغية، ودراسة إمكانية جدولة لتأهيل أئمة المساجد فى إطار خطة ميثاق العلماء باللغة الأمازيغية يشرف علي...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©