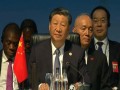الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
خواطر شخصية عن صديق معتقل

حسن نافعة
تربطنى بالسفير محمد رفاعة الطهطاوى، مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق، علاقة صداقة حميمية تمتد لسنوات طويلة. فقد تعرفت عليه لأول مرة حين وجه إلىَّ دعوة لإلقاء عدد من المحاضرات فى المعهد الدبلوماسى التابع لوزارة الخارجية، مثلما اعتاد بعض من سبقوه فى إدارة هذا المعهد. ثم راحت العلاقة تنمو وتترسخ، بعد أن جمعتنا مناسبات عدة داخل مصر وخارجها. فى حواراتى الدائمة معه، التى كان من الطبيعى أن تتطرق لمناقشة الأوضاع السياسية، لم يخف الطهطاوى تعاطفه مع التيار الإسلامى بصفة عامة ومع جماعة الإخوان بصفة خاصة، لكننى أعتقد أنه لم ينخرط تنظيميا فى أى من فصائل هذا التيار حتى بعد تركه العمل بوزارة الخارجية. ورغم ما كان يظهر بيننا من تباين كبير أحيانا فى وجهات النظر، إلا أن الخلاف فى الرأى لم يفسد للود بيننا قضية، ما جعل للصداقة التى جمعتنا مذاقا خاصا وربما فريدا. لم أتحمس شخصيا لأى من المرشحين فى البداية، لكننى قررت لاحقا إعلان تفضيلى للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، اعتقادا منى أنه ربما يكون الأقدر على تخفيف حدة استقطاب خطر كان قد بدأ يطفو على سطح الحياة السياسية فى مصر ويهدد استقرارها. أما صديقى فقد أعلن منذ اللحظة الأولى دعمه للدكتور مرسى، ما وضعنا على طرفى نقيض. فإسقاط أبوالفتوح كان الهدف الأول لجماعة الإخوان، وربما الدافع الأساسى وراء قرارها خوض الانتخابات، غير أن هذا التناقض فى المواقف السياسية لم يؤثر على متانة العلاقة الشخصية بيننا. لم أندهش كثيرا حين وقع اختيار الدكتور مرسى على السفير الطهطاوى كرئيس للديوان، واعتبرته اختيارا موفقا. وحين اتصلت بصديقى مهنئا، دعانى إلى فنجان قهوة فى مكتبه، فلبيت دعوته مرحبا، ثم استمر التواصل بيننا عبر الهاتف، لكن على فترات متباعدة، حرصا منى على وجود مسافة تفصلنى عن السلطة، أيا كانت، وعلى أن يظل الخط الفاصل بين العام والخاص قائما. ورغم مشاركتى فى عدة لقاءات دعا إليها الدكتور مرسى فى قصر الاتحادية فى بداية عهده، للتأكيد على حرصه على التواصل مع القوى الوطنية، إلا أننى لم أحاول الاتصال بصديقى هناك، باستثناء المرة الأخيرة التى أحسست خلالها بأن الأمور لا تسير فى الاتجاه الصحيح، وبأن عواصف كثيرة تتجمع فى الأفق، وبأن الواجب يفرض على مصارحة صديقى بما يدور فى خاطرى. فى هذه المرة طلبت من أحد مساعدى الرئيس فى نهاية اللقاء أن يبلغ السفير طهطاوى بأننى موجود فى القصر وبأننى أرغب فى زيارته، إن كان وقته يسمح، فجاء الرد فوريا ومرحبا. استغرق اللقاء فى ذلك اليوم قرابة الساعتين، حاولت خلاله التعبير عن عدم سعادتى بالطريقة التى تدار بها الأمور، وقلت بوضوح إننى أستشعر قدوم العاصفة بسبب عدم حرص القيادة السياسية على إصدار دستور بالتوافق. لم تكن وجهة نظرى هذه رجما بالغيب، وإنما مستمدة من خبرة مباشرة فى التعامل مع الجمعية التأسيسية كعضو فى لجنة الخبراء. أنصت صديقى باهتمام، ووعد بنقل وجهة نظرى للرئيس، لكن تطورات الأحداث بعد ذلك أوضحت أن كلامى ذهب أدراج الرياح ولم يؤخذ على محمل الجد. فبعد أقل من أسبوعين أصدر الدكتور مرسى «إعلانا دستوريا» حصن به الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وكان بمثابة الشرارة التى أشعلت فتيل الأزمة التى حذرت من احتمالات تفجرها. حين زحفت الجماهير بأعداد غفيرة إلى قصر الاتحادية، وهى فى حالة غضب عارم من رئيس منحه الإعلان الدستورى سلطة «الحاكم الإله» على النمط الفرعونى، وردت جماعة الإخوان بحشد مضاد لأنصارها، بدت مصر على وشك الدخول فى حرب أهلية. ولأننى لم أذق طعم النوم فى تلك الليلة، فقد خطر لى أن أتصل بالسفير الطهطاوى لأعبر له عن استيائى مما يجرى، ولأحذر من عواقبه المحتملة، وهو ما فعلته فى صباح اليوم التالى. اعتذرت له عن الاتصال فى مثل هذه الساعة المبكرة من صباح يوم جمعة، وذكرته بحوارنا السابق فى مكتبه، وعبرت له عن مخاوفى من عواقب ما يجرى. ولأن النبرة البادية فى صوتى تعلو حتى كادت تصل إلى مرتبة الصياح. غير أن صديقى الدبلوماسى كان أوسع صدرا وأكثر حكمة، واستطاع تهدئة ثورة غضبى، مؤكدا أن رسالتى وصلت بوضح، وأنه يتفهم دوافعها الوطنية، وسينقلها بحذافيرها للرئيس. دارت الأيام، وجرى خلالها ما جرى، إلى أن ظهرت حركة «تمرد»، فأعلنت تأييدى لها منذ اللحظة الأولى دون تردد، وحين تحرك الجيش فى 3 يوليو وأعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسى خارطة طريق جديدة، أحسست بأن عبئا ثقيلا أزيح عن كاهل مصر. غير أن هذا الشعور «السياسى» بالارتياح لإزاحة جماعة الإخوان من السلطة لم يستطع أن يخفى شعورا «إنسانيا» بالقلق على ما قد تحمله المرحلة التالية من تجاوزات، وهو ما دفعنى لكتابة عدد من الأعمدة حملت عناوين من قبيل: «ليس تفويضا بالقتل»، «أفرجوا عن مرسى أو حاكموه»... إلخ. غير أن ذلك كله لم يكن كافيا لإزاحة صراع نفسى راح يجتاحنى بعد أن أصبح صديقى الحميم معتقلا وراء القضبان، ورحت أتساءل بينى وبين نفسى: كيف يمكن للصديق أن يتصرف فى مثل هذه الأحوال؟ لم أتردد لحظة واحدة وقلت لنفسى: الصداقة أن تعلو فوق السياسة.. بادرت بالاتصال هاتفيا باللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، الذى أعرفه منذ أيام المجلس الاستشارى، وسألته إن كان بوسعه المساعدة فى استخراج تصريح شخصى لزيارة صديقى المعتقل. بعد حديث لم يخل من كلمات المجاملة، اعتذر الرجل بأدب، مؤكدا أن هذا موضوع يدخل فى اختصاص النائب العام وحده. ولأننى لا أعرف النائب العام شخصيا، فقد هدانى تفكيرى إلى الاتصال بزميلى وصديقى، الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى البارز والمنتخب حديثا رئيسا لجامعة القاهرة. بدا الدكتور نصار وقتها متفائلا جدا، ليس فقط بإمكانية الحصول على تصريح لى بزيارة صديقى المعتقل، وإنما أيضا بإمكانية إطلاق سراحه بسرعة. وحين مرت أيام طويلة دون أن يتصل بى، أدركت أن الأمر أعقد حتى مما تصور هو. لم أستسلم، ورحت أحاول مع آخرين، غير أن كل جهودى راحت هباء. لم أكن أتصور قط أن الحصول على تصريح بزيارة صديق معتقل سياسيا أصبح مستحيلا فى مصر الثورة. غير أن ما أثار استهجانى حقا هو استغراب البعض من إصرارى على استمرار المحاولة، وتحذيرى مما قد تنطوى عليه من مخاطر قد تهدد مستقبلى السياسى! ذكرت بعض وسائل الإعلام، منذ حوالى أسبوعين، أن التحقيقات مع السفير محمد رفاعة الطهطاوى أثبتت براءته من التهمة الموجهة إليه بالمشاركة فى احتجاز وتعذيب مواطنين فى قصر الاتحادية، فتقرر إخلاء سبيله. اتصلت بأسرته على الفور للتأكد من صحة الخبر، فقيل لى إنهم سمعوا بالخبر من وسائل الإعلام، وعلمت أنه لم يسمح لأحد بزيارته ولا يعرفون حتى مكان احتجازه. لم تكد تمر أيام قليلة، وربما ساعات، على نشر هذا الخبر، حتى نقلت وسائل الإعلام خبرا آخر مفاده أنه تقرر حبس السفير الطهطاوى خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق فى اتهامات جديدة تتعلق بالتخابر مع حماس! أدركت على الفور أن الاستهانة بالقانون وبعقول الناس وصلت حد الخطر.لم يبق فى نهاية هذه الخواطر الشخصية، التى قدرت أنه ربما يكون فى البوح بها بعض النفع العام، وأعتذر للقارئ إن لم تكن قد حققت الفائدة المرجوة منها، سوى المطالبة بالإفراج الفورى، ليس فقط عن السفير رفاعة الطهطاوى، وإنما عن كل من لم تتوافر دلائل جدية تكفى لتقديمه إلى المحاكمة.
GMT 14:49 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
«آخر الكلام»GMT 14:48 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
مش معقول.. ستة دنانير فطور صحن الحمص!GMT 14:47 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
روسيا: المفاجأة الكبرى أمام ترمبGMT 14:45 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
ثلث نساء العالم ضحايا عنفGMT 14:44 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
تنظيم «الإخوان» ومعادلة «الحرية أو الطوفان»GMT 14:40 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
أوكرانيا...اليوم التالي بعد الألفGMT 14:38 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
حسين فهمى يوارب الباب ويسمح بالفيلم الإيراني!!GMT 14:37 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
أولويات ترمب الخارجية تتقدّمها القضية الفلسطينية!وزارة الإقتصاد والمالية المغربية تعلن إرتفاع المداخيل الضريبة بنسبة 12,5 في المائة
الرباط - المغرب اليوم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أ�...المزيدرافائيل نادال يختتم مشواره ويلعب مباراته الأخيرة في كأس ديفيز 2024
لندن - المغرب اليوم
يشارك لاعب التنس الإسباني الشهير " بطولة رافائيل نادال " في التنس الأخيرة في مسيرته الرائعة هذا الأسبوع، حيث سيمثل بلاده في كأس ديفيز 2024. يعتبر الإسباني البالغ من العمر 38 عاما، والذي يحتل المركز الثاني بعد " ...المزيدميركل تحذّر و تعبّر عن قلقها من سيطرة ماسك على 60% من الأقمار الصناعية
برلين - روان محمود
بعد كشفها عن تفاصيل لقاءاتها السابقة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال مقتطفات من مذكراتها التي ستصدر الأسبوع المقبل، أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن قلقها على النظام الديمقراطي مع ...المزيدالحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الذي قدمه وزير الشباب والثقافة
الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح بلاغ للوزا...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©