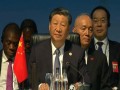الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
أسامة الباز

حسن نافعة
شخصية غير تقليدية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تميزت بالبساطة والتواضع والتلقائية فى التعامل مع الآخرين، دون تمييز. احترف «الباز» الدبلوماسية كمهنة، لكن عشقه الحقيقى كان للثقافة والفن. وحين اقتربت منه أيقنت أنه من الشخصيات القليلة التى يمكننى أن أختلف معها بشدة، دون أن أفقد احترامى لها، وأن أجاهر بهذا الاختلاف وأنا مطمئن تماماً إلى أننى لن أتلقى بسببه طعنة من الخلف أو أتعرض للتآمر والتشويه. سمعت كثيراً عن أسامة الباز، قبل أن ألتقى به شخصياً، وشد انتباهى ما جاء فى مذكرات محمد إبراهيم كامل، وزير الخارجية الأسبق، عن دوره فى مفاوضات كامب ديفيد. وشاءت المصادفات أن أتقابل، عام 1982 مع أحد أساتذته فى جامعة هارفارد، وحين تطرق حديثى معه حول مفاوضات كامب ديفيد ودور أسامة الباز، إلى أن الأستاذ يعرف تلميذه جيداً توقف مطولاً عند بعض مفاتيح شخصيته، وعلمت منه أشياء كثيرة لافتة منها مثلاً أن «أسامة» كان طباخاً ماهراً، وأن اهتمامه بإعداد الوجبات الشهية فاق اهتمامه بالدراسة!. تعرفت عليه لأول مرة حين قدمنى إليه لطفى الخولى، قبيل ندوة عقدت فى «الأهرام»، عام 1983، لكننى لم أقترب منه على المستوى الشخصى إلا عام 1986. أما المناسبة فكانت دعوة وجهتها للسيد الصادق المهدى، لإلقاء محاضرة عن العلاقات المصرية السودانية فى نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، حين كنت مسؤولا عن النشاط الثقافى للنادى، وعضو مجلس إدارته المنتخب. ولأن حزب الأمة الذى يتزعمه الصادق المهدى كان على وشك الفوز بالأغلبية البرلمانية فى الانتخابات التشريعية السودانية التى جرت فى ذلك العام، فقد خشى حزب الاتحاد، المنافس، أن يسعى الصادق المهدى إلى استغلال زيارته للقاهرة لتحقيق مكاسب سياسية ترجح كفة حزبه. لذا سارع زعيمه بالاتصال بالرئيس مبارك الذى طلب بدوره من رئيس جامعة القاهرة أن يسعى لتأجيل الزيارة، وهو ما تسبب فى أزمة دبلوماسية مكتومة سعى الدكتور «أسامة» لاحتوائها، قبل أن تنفجر، ومن هنا كانت مبادرته بالاتصال بى. مازلت أذكر تفاصيل لقائى الأول به فى مكتبه بمبنى وزارة الخارجية القديم، وكأنه حدث بالأمس القريب، فحين دخلت عليه وجدته غاطسا بين أكوام من الملفات، مادا ساقيه فوق منضدة مقابلة، بعد أن تخلص من جواربه الملقاة إلى جوار حذائه. هم واقفا، وسلم علىَّ بحرارة، وحين لاحظ دهشتى واستغرابى انفرجت أساريره عن ابتسامة عريضة، ثم قال بصوته المميز: اجلس هنا يا صديقى، وتخفف من ملابسك مثلى، إن أردت. تسربت إلى أعماقى مشاعر ألفة سمحت للقاء الأول بيننا بأن يمتد لساعتين وأن يثمر. تكررت لقاءاتى بالدكتور «أسامة»، بعد ذلك، فى مناسبات مختلفة أدرك هو من خلالها مدى حرصى على استقلالى، فاستقرت بيننا علاقة قامت على احترام متبادل، مع التسليم بالحق فى الاختلاف. لم يحل خلافى معه فى الرأى حول بعض القضايا دون إقدامه على توجيه الدعوة لى فى مناسبات متعددة للمشاركة فى لقاءات فكرية كان يحرص على عقدها مع شخصيات سياسية مهمة على هامش زياراتها الرسمية للقاهرة، أذكر من بينها لقاءات جرت مع معمر القذافى، والأمير سعود الفيصل، وجون جارانج وغيرهم كثيرين، لكننى كثيرا ما التقيته مصادفة وهو يسير على قدميه فى الشارع، بلا أى حراسة، أو يتناول عشاءه فى مطعم، أو يشهد عرضا مسرحيا أو يفتتح بنفسه أحد المعارض الفنية، وكان يسعد كثيرا بالمداعبة، ويرد عليها بأحسن منها! لا أتذكر المناسبة التى التقيته فيها للمرة الأخيرة، دون أن أدرى، لكن من المؤكد أنها كانت منذ سنوات، ربما فى حفل غداء أقامه أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق، على شرف السفير رفاعة الطهطاوى بمناسبة بلوغه سن الإحالة إلى المعاش. تبادلنا الحديث لدقائق أمام المصعد، عند المغادرة. بدا لى وقتها محبطا بعض الشىء. رجوته أن يهتم بكتابة مذكراته الشخصية، وأن يفتح كنز أسراره الدفين والثمين لتستفيد منه أجيال المستقبل، لم أشعر بحماسه للفكرة، ولا أعرف ما إذا كان قد وجد لديه الوقت أو الرغبة للقيام بهذه المهمة، وأتمنى أن يكون قد فعل. كان أسامة الباز دبلوماسياً رفيع المستوى، ومثقفاً واعياً، وإنساناً محباً للحياة، لكنه قبل ذلك وبعده كان وطنياً عاشقاً لتراب مصر. تغمده الله برحمة واسعة، وعزائى لأسرته الصغيرة ولوطنه الكبير.
GMT 14:49 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
«آخر الكلام»GMT 14:48 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
مش معقول.. ستة دنانير فطور صحن الحمص!GMT 14:47 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
روسيا: المفاجأة الكبرى أمام ترمبGMT 14:45 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
ثلث نساء العالم ضحايا عنفGMT 14:44 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
تنظيم «الإخوان» ومعادلة «الحرية أو الطوفان»GMT 14:40 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
أوكرانيا...اليوم التالي بعد الألفGMT 14:38 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
حسين فهمى يوارب الباب ويسمح بالفيلم الإيراني!!GMT 14:37 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
أولويات ترمب الخارجية تتقدّمها القضية الفلسطينية!وزارة الإقتصاد والمالية المغربية تعلن إرتفاع المداخيل الضريبة بنسبة 12,5 في المائة
الرباط - المغرب اليوم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أ�...المزيدرافائيل نادال يختتم مشواره ويلعب مباراته الأخيرة في كأس ديفيز 2024
لندن - المغرب اليوم
يشارك لاعب التنس الإسباني الشهير " بطولة رافائيل نادال " في التنس الأخيرة في مسيرته الرائعة هذا الأسبوع، حيث سيمثل بلاده في كأس ديفيز 2024. يعتبر الإسباني البالغ من العمر 38 عاما، والذي يحتل المركز الثاني بعد " ...المزيدميركل تحذّر و تعبّر عن قلقها من سيطرة ماسك على 60% من الأقمار الصناعية
برلين - روان محمود
بعد كشفها عن تفاصيل لقاءاتها السابقة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال مقتطفات من مذكراتها التي ستصدر الأسبوع المقبل، أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن قلقها على النظام الديمقراطي مع ...المزيدالحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الذي قدمه وزير الشباب والثقافة
الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح بلاغ للوزا...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©