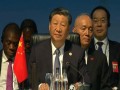الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الدين والسياسة في ذاكرة مواطن

حسن نافعة
ولد صاحبنا فى أسرة متوسطة الحال بإحدى قرى البحيرة. كان والده رجلاً متديناً دون تكلف، وكان يحرص دائماً على إيقاظه مبكرا كل يوم للذهاب إلى مسجد القرية القريب ليؤديا معاً صلاة الفجر، وما إن يعودا إلى المنزل حتى يبدأ الأب فى تلاوته اليومية لما تيسر من بعض سور القرآن الكريم، وبصوت عال كان يسمعه أهل البيت الكبير جميعاً. فى هذه الأجواء الروحانية المشبعة بترانيم أذان الفجر وتلألأ قطرات الندى فوق أوراق حقول خضراء تمتد بلا نهاية، نمت علاقة إنسانية عميقة وصلت ذروتها مع الرحيل المفاجئ للأب قبل أن يكمل الابن عامه السابع عشر، وترسبت فى وجدان الطفل لوحة رائعة عن وطن جسدته طفولة رسمت فى مخيلته صورة مئذنة شامخة وحقول خضراء، ظل صاحبنا يختزنها فى ذاكرته كلما أحس بالغربة فى أوطان بعيدة أتيح له أن يذهب إليها فيما بعد دارساً أو زائراً. كانت القرية التى قضى فيها صاحبنا طفولته وعاش فيها حتى التحاقه بالجامعة، تعبد ربها وتمارس شعائر دينها جنباً إلى جنب مع أقباط تفاعلوا مع مسلميها دون أن يحس أحد بأى نوع من التمييز، وهو ما لمسته بنفسى من خلال الخبرة المباشرة. فقد أقامت فى نفس القرية أسرة مسيحية كانت تمتلك قطعة أرض تفصل بين قطعتين تملكهما أسرة صاحبنا. ولأن رب الأسرة القبطية كان يمتهن مهنة أخرى بخلاف الزراعة فقد تكفلت أسرته بزراعة قطعة الأرض المشار إليها، وكان من الطبيعى فى هذا السياق أن تنمو بين الأسرتين علاقة أعمق من علاقة الجوار العادية. وقد عاش صاحبنا هذه التجربة بنفسه ورأى كيف كان الجميع يتقاسمون الطعام والشراب ويتبادلون الزيارات والتهانى فى المناسبات دون أن يشعر ألبتة بوجود أى نوع من التمييز. لم تختلف الصورة كثيراً حين انتقل صاحبنا إلى المدينة ليلتحق بالجامعة فى بداية ستينيات القرن الماضى. فقد كانت اتحادات الطلاب فى ذلك الوقت تضم أقباطاً منتخبين، وكان الجميع يتعامل معهم بندية وبطريقة طبيعية، بما فى ذلك تبادل النكات التى تسخر من الأقباط والمسلمين دون أى حساسية. وكان من بين «شلة» صاحبنا شاب قبطى كثيراً ما كان يلتقيه فى منزله، ولم تكن والدته تكتفى بالترحيب به لكنها كانت تصر على استضافته والترحيب به حين لم يكن صديقه القبطى موجوداً بالمنزل وتطلب منه انتظاره حتى يعود كأنه أحد أفراد العائلة. وبعد أن تخرج صاحبنا من الجامعة وبدأ يخوض تجربة الحياة بنفسه وحيداً، شاءت الأقدار أن يرتبط عاطفيا بشابة فرنسية جميلة اقترن بها وأصبحت أماً لأولاده، وارتبط مع أسرتها الكاثوليكية بروابط صداقة ظلت عميقة رغم الانفصال وصمدت حتى بعد رحيل زوجته عن الدنيا منذ أعوام قليلة. استوعب صاحبنا شعار «الدين المعاملة»، واعتاد أن يسمع والده يردده كثيرا فى طفولته. ورغم الاهتمام الواضح بممارسة الشعائر الدينية، فإن الورع والتقوى والانسجام التام بين الأقوال والأفعال كان أكثر ما جذب الناس إلى والد صاحبنا وحبب إليه جميع سكان القرية. ومازال صاحبنا يتذكر كيف كان ينصت إلى والده بانتباه شديد حين كان يؤكد خصوصية العلاقة بين العبد وربه، لأن الله هو وحده الأعلم بما تطوى السرائر وبما تخفى الصدور، وبالتالى يتعين أن يكون له وحده حق محاسبة العباد، ولأن لكل إنسان تجربة حياتية خاصة يستمد دروسها من تفاعل عوامل متداخلة، تؤثر فيها النشأة والتحصيل العلمى والخبرة الشخصية المباشرة فى التعامل مع المواقف والأحداث، فقد استطاع صاحبنا من تجربته الحياتية الخاصة التمييز بين أمرين على جانب كبير من الأهمية. الأمر الأول: التمييز بين الأقوال والأفعال، حيث لا يجوز الحكم على الأشخاص من واقع أقوالهم فقط وإنما يتعين إدخال أفعالهم فى الاعتبار للحكم على درجة ما يتمتعون به من اتساق فى شخصياتهم، والأمر الثانى: التمييز بين الظاهر والباطن، حيث لا يجوز الحكم على الأشياء من واقع ما نراه منها ظاهرا على السطح، لأن الجزء الغاطس فى الأعماق قد يكون الأكبر والأهم. وقد استطاع صاحبنا، استنادا إلى هذا التمييز، أن يرسم فى ذهنه، وفى وجدانه أيضاً، حدوداً فاصلة بين «الدينى» و«السياسى»، ساعدته فى ذلك دروس عدة استخلصها صاحبنا من مشاهد أربعة مر بها عبر تجربته الحياتية فى مراحل الطفولة والشباب والرجولة والكهولة. المشهد الأول: كُتَّاب القرية. وكان مملوكا لشيخ ضرير يقوم فيه بتحفيظ القرآن. ولأن صاحبنا، الذى حفظ فيه معظم أجزاء القرآن، لم يكن من الأشقياء أو البلداء فقد أصبح مقرباً من الشيخ الضرير الذى كان عادة ما يمنحه شرف الإمساك بيده لاصطحابه إلى المسجد. وذات يوم دخل صاحبنا إلى غرفة الشيخ المعتمة، ربما ليشكو إليه شيئا ما، فوجد الشيح يمسح بيديه على شعر فتاة شابة أجلسها على ركبتيه. ولم يدرك صاحبنا مغزى ما يدور إلا حين ظهر الارتباك على الشيخ بمجرد أن أحس بوجود غريب، فارتاب الصبى فى الأمر. ومع ذلك لم يكن باستطاعة صاحبنا أن يدرك حقيقة ودلالة ما حدث إلا لاحقا، وحين أدركه استخلص أن حفظ القرآن أو الإكثار من الصلاة لا يحولان بالضرورة دون إقدام البشر على ارتكاب الخطيئة أو المعصية، وإن الله وحده هو الغفور الرحيم. المشهد الثانى: الجامعة. وفيها بدأ صاحبنا يكثر من القراءة، خاصة فى التاريخ السياسى للمجتمعات، وراح إدراكه لطبيعة العلاقة بين الدين والسياسة يتأصل ويتعمق شيئا فشيئا. وكانت هذه القضية قد بدأت تشغله كثيرا حين قرأ فى مرحلة مبكرة من شبابه كتاب أحمد بهاء الدين «أيام لها تاريخ»، خصوصا الفصول التى تناولت الجدل الذى دار حول كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبدالرازق، وكذلك حول قصة زواج الشيخ على يوسف، المنتمى إلى عامة الشعب، من صفية بنت السادات، وكانت من الأشراف. وبدأ صاحبنا يقتنع تدريجيا عبر رحلته الدراسية بأن الصراع الذى دار بين المسلمين منذ وفاة النبى، عليه الصلاة والسلام، حتى أيامنا هذه، بما فى ذلك زمن الخلفاء الراشدين، كان صراعاً على السلطة، أى سياسى بامتياز، وأن جميع الأطراف التى شاركت فيه حاولت، كل بطريقته الخاصة، توظيف الدين لتعظيم فرصها فى الوصول إلى السلطة وليس دائما أو بالضرورة لإعلاء شأن الدين. واقتنع صاحبنا بأن هذه الحقيقة كانت ولاتزال وستظل باقية إلى الأبد، ولا حل لها إلا بفصل الدعوىّ عن السياسى فصلا تاما. المشهد الثالث: باريس. فحين توجه صاحبنا إلى أسرة صديقته الفرنسية التى كان قد تعرف عليها فى القاهرة وأحبها ليطلب منها يد ابنتها، قوبل فى البداية برفض قاطع من جانب والدها، غير أن والدتها استطاعت تدريجيا تليين موقفه إلى أن وافق فى النهاية. واكتشف صاحبنا، من خلال احتكاكه بهذه الأسرة الفرنسية العريقة، أن الأم شديدة التدين وأنها لم تتناول الخمر فى حياتها قط لأسباب تقول إنها دينية، رغم أن دينها لا يحرم ذلك شكلا، ورفضت تحديد النسل وأنجبت ثمانية أطفال تفرغت لرعايتهم وكرست حياتها من أجلهم، ولم تقم بأى وظيفة أخرى رغم حصولها على «الأجرجاسيون» فى الأدب، وهى درجة أعلى من شهادة الدكتوراه. وقد استطاع صاحبنا أن يصبح صديقا للأسرة كلها فيما بعد، وليس للأم فقط، واستمرت صداقته بها قوية وعميقة حتى بعد الانفصال عن زوجته الفرنسية. وتعلم من هذه التجربة شيئا مهما جدا وهو أن الفضيلة ومكارم الأخلاق ليستا مقصورتين على دين بعينه، وأن الشرف والفضيلة والكرامة والتسامح وغيرها هى قيم إنسانية عامة، قد تكون الأديان على اختلاف أنواعها أحد مصادرها الرئيسية لكنها ليست مصدرها الوحيد. المشهد الرابع: الوداع الأخير. حين علم صاحبنا بوفاة زوجته التى كان يعلم أنها تعانى من المرض اللعين فى السنوات الأخيرة وكان على اتصال بها، توجه فى أول طائرة إلى باريس لحضور القداس فى وجود أبنائهما وأصدقائها وأصدقاء الأسرة، ثم نقل الجثمان إلى منزل الأسرة الريفى، على بعد حوالى 400 كيلومتر من باريس كى يدفن فى مقابر الأسرة، وهناك تبين وجود وصية بأن تتم مراسم الدفن وفقاً للشعائر الإسلامية، وأن الأسرة لا تمانع، وكان مشهداً مهيباً. وبينما كان الجسد الطاهر يوارى التراب كانت آيات القرآن تتلى فى هذا المكان الذى ربما لم يدفن فيه شخص مسلم من قبل على الإطلاق، وكانت الأسرة بكاملها تصطف احتراما وتسمع التلاوة فى خشوع حتى دون أن تعى ما يقال، بينما البعض يحاول التحكم فى دموعه. وقتها أدركت أن أعظم القيم التى يمكن لأى إنسان أن يؤمن بها هى قيم الحرية والتسامح، وأنه لن يكون بوسع العالم أن يعيش فى سلام إلا إذا آمنت كل شعوب الأرض بهاتين القيمتين الإنسانيتين الكبيرتين إيماناً حقيقياً. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"
GMT 14:49 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
«آخر الكلام»GMT 14:48 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
مش معقول.. ستة دنانير فطور صحن الحمص!GMT 14:47 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
روسيا: المفاجأة الكبرى أمام ترمبGMT 14:45 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
ثلث نساء العالم ضحايا عنفGMT 14:44 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
تنظيم «الإخوان» ومعادلة «الحرية أو الطوفان»GMT 14:40 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
أوكرانيا...اليوم التالي بعد الألفGMT 14:38 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
حسين فهمى يوارب الباب ويسمح بالفيلم الإيراني!!GMT 14:37 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
أولويات ترمب الخارجية تتقدّمها القضية الفلسطينية!وزارة الإقتصاد والمالية المغربية تعلن إرتفاع المداخيل الضريبة بنسبة 12,5 في المائة
الرباط - المغرب اليوم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أ�...المزيدرافائيل نادال يختتم مشواره ويلعب مباراته الأخيرة في كأس ديفيز 2024
لندن - المغرب اليوم
يشارك لاعب التنس الإسباني الشهير " بطولة رافائيل نادال " في التنس الأخيرة في مسيرته الرائعة هذا الأسبوع، حيث سيمثل بلاده في كأس ديفيز 2024. يعتبر الإسباني البالغ من العمر 38 عاما، والذي يحتل المركز الثاني بعد " ...المزيدميركل تحذّر و تعبّر عن قلقها من سيطرة ماسك على 60% من الأقمار الصناعية
برلين - روان محمود
بعد كشفها عن تفاصيل لقاءاتها السابقة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال مقتطفات من مذكراتها التي ستصدر الأسبوع المقبل، أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن قلقها على النظام الديمقراطي مع ...المزيدالحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الذي قدمه وزير الشباب والثقافة
الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح بلاغ للوزا...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©