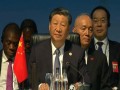الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
التشريع وكتابة الدساتير

حسن نافعة
التشريع عملية تقوم بها برلمانات يتعين أن تكون منتخبة بالضرورة، أما صناعة الدساتير فهى عملية تتولاها جمعيات تأسيسية قد تكون منتخبة وقد لا تكون، ولأن الهدف من سن القوانين هو تنظيم شؤون الحياة اليومية للمواطنين، وهى أمور قابلة للتغير بطبيعتها، فمن الطبيعى أن يُشترط فى كل من يشارك فى صناعتها أن تكون له صفة «نيابية» أو «تمثيلية». أما «الجمعيات التأسيسية» التى تكلف بكتابة الدساتير فمهمتها مختلفة. ولأن الدستور يحدد نظام وقواعد إدارة اللعبة السياسية بين فرق متعددة تتصارع على السلطة وتتنافس للفوز بها فى دورات محددة، وليس تشريعاً قابلاً للتغيير مع تغير الأغلبية البرلمانية، يتعين أن تتمتع نصوصه بثبات نسبى لضمان استقرار النظام السياسى الذى يؤطره. لذا يرى كثيرون أن كتابة الدساتير هى مهمة «الخاصة» وليس «العامة»، وبالتالى يُشترط أن تتوافر فى عضو «الجمعية التأسيسية» مؤهلات فنية خاصة حتى ولو لم تكن له صفة تمثيلية. الوضع النموذجى هو الجمع بين الحسنيين، غير أنه ينبغى أن يكون واضحاً فى الوقت نفسه أن الصفة التمثيلية المطلوبة فى عضو الجمعية التأسيسية قد لا تكون بالضرورة هى ذاتها المطلوبة فى عضو البرلمان، ولأن الهيئة المكلفة بكتابة الدستور، خصوصا فى أعقاب الثورات، يتعين أن تمثل المجتمع بكل تياراته السياسية والفكرية، ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية، ومناطقه وأقلياته الدينية والعرقية، إن وجدت، فقد يؤدى ربطها بالبرلمان إلى الإخلال بالتوازن المطلوب بين ممثلى هذه الفئات والقطاعات المختلفة، وهذا هو ما حدث بالفعل فى التجربة المصرية والتى أدت إلى كل هذا الارتباك الذى تشهده الساحة السياسية حاليا. فقد اتسمت التجربة المصرية فى كتابة الدستور بنوعين من الخلل نجم عن الربط الذى أحدثته المادة 60 من الإعلان الدستورى بين الجمعية التأسيسية والبرلمان، الأول: هيمنة تيار سياسى وفكرى معين أغرته قوته العددية فى البرلمان، والتى انعكست بطبيعة الحال على وزنه فى الجمعية التأسيسية، بالسعى لكتابة دستور على مقاسه هو وليس على مقاس المجتمع ككل. والثانى: افتقاد الجمعية للعدد الكافى من الخبرات الفنية المتنوعة واللازمة لكتابة دستور محكم ومنضبط ومتوازن. وفى تقديرى أن موقف تيار الإسلام السياسى بصفة عامة، والتيار السلفى، بصفة خاصة من قضية الشريعة الإسلامية وإصراره على تضمين الدستور نصوصاً تضمن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما يراها، يعكس خلطا واضحا بين التشريع وصناعة الدستور. فإذا كانت جميع القوى السياسية تقبل بنص المادة الثانية من دستور 1971 التى تعتبر المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، تنتفى الحاجة فى تقديرى لتعريف معنى مبادئ الشريعة الإسلامية فى متن الدستور، ويصبح الإصرار على وجود هذا مثل التعريف، والذى قد يثير خلافا قد يحول دون الوصول إلى التوافق المطلوب، تزيدا لا ضرورة له. إذا كان التيار السلفى يصر على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو موضوع يثير خلافات كثيرة حتى بين فقهاء المذاهب الإسلامية المختلفة، فمكان الحديث عن هذه الأحكام هو البرلمان وليس الجمعية التأسيسية. فبوسع التيار الإسلامى، إن وجد نصا فى القوانين المطبقة يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أن يطرح فى البرلمان من تشريعات جديدة أو من تعديلات على التشريعات القائمة. ولأن النقاش حول أحكام الشريعة الإسلامية سيكون فى هذه الحالة أجدى وأكثر تحديدا، لأنه سيتعلق بقضايا أو أمور ملموسة ويمكن قياس الآثار المترتبة على تطبيقها، فإن هناك ما يحول دون قيام الأغلبية البرلمانية، خصوصا فى ظل وجود وبقاء نص المادة الثانية من الدستور كما هو، بإقرار التعديلات التشريعية المقترحة على الفور، إذا ما اقتنعت بضرورتها وجدواها وتوافر إجماع فقهى حولها، وأن تصبح نافذة المفعول بمجرد تصديق رئيس الدولة عليها. يبدو أن البعض لم يستوعب بعد طبيعة الفرق بين الدستور والقانون ولم يدرك بعد أن النصوص الدستورية لا تطبق نفسها بنفسها وإنما تحتاج إلى قانون لا يمكن أن تصنعه إلا أغلبية برلمانية. وإذا كان التيار السلفى يرى أن وجود نص المادة الثانية من الدستور لم يؤد إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما ينبغى أن تكون فعليه أن يدرك أن السبب لا يعود إلى قصور فى النصوص الدستورية ولكن إلى غياب أغلبية برلمانية تستطيع أن تقوم بالمهمة كما يراها هو. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"
GMT 14:49 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
«آخر الكلام»GMT 14:48 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
مش معقول.. ستة دنانير فطور صحن الحمص!GMT 14:47 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
روسيا: المفاجأة الكبرى أمام ترمبGMT 14:45 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
ثلث نساء العالم ضحايا عنفGMT 14:44 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
تنظيم «الإخوان» ومعادلة «الحرية أو الطوفان»GMT 14:40 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
أوكرانيا...اليوم التالي بعد الألفGMT 14:38 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
حسين فهمى يوارب الباب ويسمح بالفيلم الإيراني!!GMT 14:37 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
أولويات ترمب الخارجية تتقدّمها القضية الفلسطينية!وزارة الإقتصاد والمالية المغربية تعلن إرتفاع المداخيل الضريبة بنسبة 12,5 في المائة
الرباط - المغرب اليوم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أ�...المزيدرافائيل نادال يختتم مشواره ويلعب مباراته الأخيرة في كأس ديفيز 2024
لندن - المغرب اليوم
يشارك لاعب التنس الإسباني الشهير " بطولة رافائيل نادال " في التنس الأخيرة في مسيرته الرائعة هذا الأسبوع، حيث سيمثل بلاده في كأس ديفيز 2024. يعتبر الإسباني البالغ من العمر 38 عاما، والذي يحتل المركز الثاني بعد " ...المزيدميركل تحذّر و تعبّر عن قلقها من سيطرة ماسك على 60% من الأقمار الصناعية
برلين - روان محمود
بعد كشفها عن تفاصيل لقاءاتها السابقة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال مقتطفات من مذكراتها التي ستصدر الأسبوع المقبل، أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن قلقها على النظام الديمقراطي مع ...المزيدالحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الذي قدمه وزير الشباب والثقافة
الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح بلاغ للوزا...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©