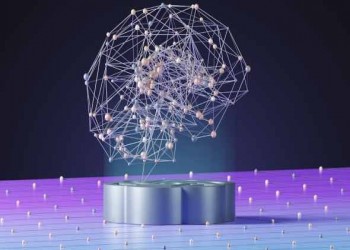الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
رهينة لا مواطن

وائل عبد الفتاح
لم أستطع منع عينى من النظر والتحديق فى المشهد.
فى تقاطع شارع رمسيس مع شارع ٢٦ يوليو.. كان الميكروباص يقف معبرا عن حالة سلطوية، معترضا الطريق كما يفعل العشوائى وصاحب السلطة، هما فقط اللذان يتصرفان فى الشوارع كما لو كانا يملكانها ونحن ضيوف بلا حقوق فيها.
كان ذلك فى الساعات الأولى من اليوم.. الخامسة تقريبا، حيث تبدأ المدينة فى استيقاظها الهادئ.. ويتسلم أهل النهار النشطاء ما يودعه أهل الليل بكل تنويعاتهم وأنواعهم وأشكالهم.
وفى هذا التوقيت وفى تلك النقطة الحيوية، كان مجموعة من المصريين (كلهم شباب) يقفون فى طابور رافعين أيديهم لأعلى، بينما أمامهم مجموعة أخرى أجسامهم أقوى يرتدون ملابس مدنية.. ويقومون بتفتيش كل منطقة فى جسد الواقفين بالطابور، الذين بدا عليهم استسلام غريب.. وانكسار لم تخفِه مشاعر القلق مما سيحدث بعد طابور التجريد، الذى وقعوا فيه رهينة وفى قلب القاهرة وعلى مرأى ومسمع من سكانها العائدين من الليل أو المقتحمين للنهار.
المشهد ليس جديدا، وتفسيره ليس ملغزا، فهؤلاء ليسوا جنود احتلال أو عصابة قطع طرق، لكنها فرق الشرطة التى تنفذ عملها الروتينى المعتاد بهذه الطريقة التى أصبحت «روتينية» إلى درجة موجعة، ومهينة، ومثيرة لفزع طويل الأمد.
فهذه الجحافل لا تحقق الأمن بهذه الطريقة.. (لكن أسلوب العمل المعتمد والمتعارف عليه.. لدرجة تجعله فوق القانون وقدرات المسؤولين، خصوصا مع دعم التنظيم السرى الساعى إلى تثبيت نصيب طائفة الشرطة فى تقسيمة السلطة).
إذن ماذا تحقق هذه الغارات التجريدية (ليس نسبة إلى الفن التجريدى.. وإنما إلى فعلها فى تجريد الناس من شروطها الإنسانية)؟
هل تحقق مثلا اللذة؟ أو التعويض عن الشعور بالدونية أو قلة الحضور الإنسانى؟ هل التصقت جحافل الشرطة بأسلوبها إلى درجة لا يفكرون فيه فى معنى أو يتصورون أنهم يؤدون عملهم؟ هل عمل الشرطة هو إفقاد الناس شعورها بالكرامة والإنسانية ليسهل حكمهم؟
لكننا لسنا فى عالم معزول ونرى إن لم نكن نسافر لنعيش حياة أخرى.. وأساليب مختلفة.. وهو ما يجعل هذه الجموع تدافع عن «إنسانيتها المفقودة» كما حدث فى جمعة الغضب على سبيل المثال.
هل يفكرون مثلا أننا يمكن أن نستسلم لهذه المشاعر القاسية والموجعة بأننا رهائن.. وأن هناك من يريد أن نعود إلى وضع تكلمت عنه كثيرا أيام مبارك، حيث يريدوننا «قطعانا تعيش فى مستوطنة عذاب كبيرة»؟ هل هى خطة لتكوين أو إعادة تكوين سلالة «الإنسان المهدور»؟
والوصف كما أشرت إليه عدة مرات هو عنوان كتاب لعالم مصرى متخصص فى علم النفس هو الدكتور مصطفى حجازى. و«الإنسان المهدور» درجة أعلى من الإنسان الذى يعيش تحت ضغط القهر والاستبداد والطغيان. وبتعبير بسيط هو إنسان يتعرّض لـ«عدم الاعتراف بالطاقات والكفاءات أو الحق فى تقرير المصير والإرادة الحرة وحتى الحق فى الوعى بالذات والوجود».
المقهور يمكنه أن يرفض ويتمرد ويثور، ورغم كل شىء فإنه يحصل على اعتراف من السلطة التى تقهره، بشرط أن يخضع لمشيئتها ورغبتها. أما المهدور فإنه يتعرض لشىء أفظع: عدم اعتراف السلطة بوجوده أصلا. تقتله، تعذّبه، تحرمه من حقوقه، تزوّر إرادته، تسرق ثرواته، وتلغى وجوده.
أسئلتى ليست تعبيرا عن وجع تحديقى فى طابور «الرهائن» الصباحى.. لكنه تفكير واقعى: هل يتصورون أن قدراتهم ستحولنا جميعا إلى سلالة مهدورة الإنسانية؟ وهذه القدرات الخرافية ستتمكن من مهمتها المذهلة بالقضاء على كم شخص يعملون بالسياسة أو يكتبون لتذكرة الجميع بالإنسانية المهدرة؟ هل يفكرون بهذه الطريقة فى الدفاع عن فشلهم فى تحقيق الأمن.. وفى الحكم الرشيد؟
نكتب هذا والداخلية غاضبة من الهجوم عليها فى الصحف، وبدلا من التحقيق فى الجرائم اليومية توجه بلاغات ضد الصحفيين.. والصحف.
نكتب هذا بينما يهرب السياسيون بمختلف أطيافهم.. من مناقشة خطة تحويلنا إلى سلالات من الرهائن لدولة طوائف، فاشلة وعاجزة.
يغرق هؤلاء فى تأويل الهجوم: هل هو صراع أجنحة؟ أم خطة إخضاع طائفة لمجموعة الحكم؟
التأويل يسرق كل إمكانات الحوار حول سؤال بسيط: كيف نمنع الإهدار اليومى لإنسانيتنا؟ كيف نهرب من مصير القطعان المهدورة؟
أما التأويلات فتسلَّ بها فى المساء والسهرة أو داوِ بها أوجاع مشاهدتك للطوابير المنتظرة لذة العاجزين.
GMT 20:18 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
كبير الجلادينGMT 20:14 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
التغيير في سورية... تغيير التوازن الإقليميGMT 20:08 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
ترمب وإحياء مبدأ مونرو ثانيةGMT 20:06 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
سوريا... والهستيرياGMT 20:04 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
لا يطمئن السوريّين إلّا... وطنيّتهم السوريّةGMT 20:01 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
هيثم المالح وإليسا... بلا حدود!GMT 19:59 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
في انتظار ترمب!GMT 19:54 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
محاكمة ساركوزي!وزير الاستثمار المغربي يكشف عن استفادة 48 مشروعاً من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية
الرباط - المغرب اليوم
كشف كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن استفادة 48 مشروعا من المنحة الترابية المخصصة للاستثمارات في الأقاليم التي تعاني نقصا في التنمية. وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الش�...المزيدالمغربية سميرة سعيد تسّتعيد ذكريات طفولتها وشغف البدايات بفيديو نادر
الرباط - المغرب اليوم
فاجأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، جمهورها بمقطع فيديو نادر، ظهرت خلاله وهي طفلة تغني على المسرح مُنذ أكثر من 50 عاماً، أغنية "كيفاش تلاقينا".وقالت سميرة سعيد، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام: "كلّما أشاهد ن�...المزيدشركة ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستغرام
واشنطن - المغرب اليوم
تعتزم شركة "ميتا" إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي.وجاء في تقرير لصحيفة (فاينانشال تايمز) أن الشركة تعتزم، لكي تحافظ على قاعدة مست...المزيدوزير الثقافة المغربي يسّتعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث
الرباط - المغرب اليوم
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن من ضمن مرامي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي. وأبرز الوزير لدى تقديم مض...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©