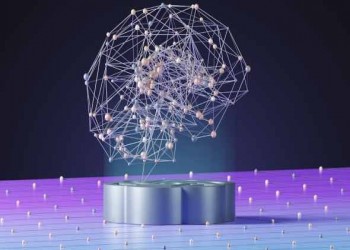الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
عن التناوب الحكومي في المغرب

بقلم : محمد الأشهب
بين القطبية الثنائية التي كان يجسدها كل من حزب «الاستقلال» و»الاتحاد الاشتراكي» المغربيين، وتلك التي تحاول أن تفرض سطوة «الأصالة والمعاصرة» في مواجهة «العدالة والتنمية» الإسلامي عشية الاستحقاقات الاشتراعية فوارق عدة، إن لم يكن في الزمن السياسي الذي لم يسمح بتداول مضاد بين الحزبين المنبثقين من امتدادات الحركة الوطنية، فعلى الصعيد الواقعي.
وإذا كان «الأصالة والمعاصرة» الذي لم يكمل عقده الأول نجح في الترويج لقطبية كهذه، استناداً إلى مبررات وجوده، القائمة على فكرة تطويق تمدد الحركات الإسلامية على ضفاف العمل السياسي الشرعي، فإن إلغاء باقي الفاعليات السياسية أو التقليل من نفوذها ينقص من شروط بناء قطبية بلا امتدادات.
في تجارب سابقة أن نظام القطبية الثنائية كان يراد به أن يبلور نوعاً من التداول السياسي بين أحزاب المعارضة، ممثلة في «الكتلة الديموقراطية» التي لم يبق منها إلا ظلالها، وبين أحزاب الموالاة التي نشأت وترعرعت في أحضان رحم الاستئناس، ما دفع إلى اختراع وصفة التناوب التي اعتبرت في حينها إنجازاً كبيراً، أدخل نخب المعارضة إلى الصف الحكومي. لكنه توقف في منتصف الطريق. واضطر الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي لأن ينفتح على مكونات من خارج «الكتلة الديموقراطية» لضمان غالبية تساند حكومته. وحين مالت الكفة لفائدة «الاستقلال» مشى زعيمه رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي على الدرب نفسه.
فيما توقعت معظم الفاعليات الحزبية أن تأتي استحقاقات العام 2011 بما يعزز فرضية استئثار أحزاب موالية بالغالبية لتحقيق الشق الثاني من التناوب، خرق «العدالة والتنمية» كل التوقعات وحصد المرتبة الأولى بفارق كبير يفصله عن بقية الأحزاب، على اختلاف مرجعياتها. وكان طبيعياً أنه استفاد من الأجواء التي أجريت فيها الانتخابات تحت ظلال حراك ما يعرف بالربيع العربي. بل إنه قطف من خطة التناوب أهم مسوغاتها، أي مجاراة هاجس التغيير الذي يحرك الناخبين.
لا جديد في الأمر، فأثناء الإعداد لطبعة التناوب تحدثت المراجع الرسمية عن وقوع البلاد في دائرة الاختناق الاقتصادي والاجتماعي الذي جرى التعبير عنه بفكرة «السكتة القلبية». والحال أن رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بن كيران لا يزال يردد أن كلفة الإصلاح في ظل الاستقرار جد مرتفعة. لكن لا بديل من الذهاب فيها إلى أبعد مدى.
في خلفيات التشخيص الدرامي للأوضاع العامة أن نبرة ما قبل التناوب كانت تروم حض الشركاء في المعارضة على الانتقال إلى موقع جديد. ساعدها في ذلك أن حدة التناقضات بين برامج الأحزاب السياسية تراجعت، على ضوء انهيار قلاع أيديولوجية. بينما تكاد النبرة الحالية تستقر عند هاجس مواصلة المشروع الإصلاحي الذي بدأ دستورياً وسياسياً وحان الوقت ليتبلور عبر جيل طموح من الإصلاحات الاجتماعية التي تتخذ من الحرب على الفساد شعاراً مركزياً.
أين مكان القطبية في هذا المنظور، ومن هم أطرافها القادرون على ربح رهان تجديد النخب والأفكار والكفاءات؟ وإلى أي مدى يبدو التقاطع القائم بين «العدالة والتنمية» و»الأصالة والمعاصرة» قابلاً لأن يتحول إلى قطبية حقيقية بمشروعات مجتمعية منسجمة مع الواقع المحلي؟
لم يكن السؤال مطروحاً، لو أن ظروف إنضاج القطبية لم تشبها مؤاخذات من بينها أن فكرة التصدي للحركات الإسلامية ذات النزعة السياسية باتت متجاوزة، بدليل تعايش أحزاب عدة من اليسار واليمين مع التجربة السياسية التي يقودها «العدالة والتنمية». يضاف إلى هذا المعطى أن الكثير من الخطوط الحمراء باتت توضع أمام الاحتمالات الممكنة في التحالفات القادمة. وحين يعلن الحزب الإسلامي أن مكانه الطبيعي سيكون إما في قيادة الحكومة أو في العودة إلى المعارضة، إنما يضيق هوامش أي تقارب محتمل. غير أن هذا الاختيار ليس بعيداً عن الإقرار بحدوث اصطفاف حزبي، قد لا يرتقي إلى مستوى القطبية المتعارف عليها في نظم التداول على الحكومات. لكنه أشبه إلى حد كبير بطبعة تناوب. وإن كان قرار الحسم ليس بيد الفاعليات السياسية بقدر ما يهم ميول الناخبين، وفي ذلك امتحان لما قبل القطبية غير المكتملة الأضلاع.
GMT 08:17 2016 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس
معنى استعادة سرت من «داعش»GMT 08:15 2016 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس
لغة الإشارات بين المغرب والجزائرGMT 08:13 2016 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس
التحالف الإسلامي ومواجهة «داعش»GMT 07:17 2016 الثلاثاء ,09 آب / أغسطس
بن كيران والاستحقاق الانتخابيGMT 06:20 2016 الأحد ,07 آب / أغسطس
الحرب ليست الخيارمكتب الصرف يفيد بارتفاع العجز التجاري بنسبة 6,5 % في المغرب
الرباط - المغرب اليوم
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نوفمبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية،...المزيدالمغربية سميرة سعيد تسّتعيد ذكريات طفولتها وشغف البدايات بفيديو نادر
الرباط - المغرب اليوم
فاجأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، جمهورها بمقطع فيديو نادر، ظهرت خلاله وهي طفلة تغني على المسرح مُنذ أكثر من 50 عاماً، أغنية "كيفاش تلاقينا".وقالت سميرة سعيد، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام: "كلّما أشاهد ن�...المزيدشركة ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستغرام
واشنطن - المغرب اليوم
تعتزم شركة "ميتا" إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي.وجاء في تقرير لصحيفة (فاينانشال تايمز) أن الشركة تعتزم، لكي تحافظ على قاعدة مست...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - المغرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©