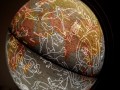الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
القرن الصيني أم زمن التحالفات المرنة؟

إميل أمين
بقلم : إميل أمين
لم يعد للعالم من حديث خلال الأيام الماضية، إلا سيرة الاختراق الدبلوماسي الكبير، ذاك الذي جرت به المقادير بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر الوساطة الصينية، والتي لطالما كانت بعيدة عن لعب مثل هذا الدور.
يتساءل الكثير من المراقبين «أهو الزمن الصيني، قد حان زمانه، أم أنه أوان القطبية الدولية المتعددة الأطراف والأطياف، والتي بات عليها أن تقبل فكرة التحالفات المرنة، من أجل عالم أكثر أمناً وأماناً، ومن غير انعزالية أو إمبريالية؟».
الشاهد، أن الإنجاز الأخير والمرموق للدبلوماسية الصينية، بات يضعها في منافسة واقعية مع نظيرتها الأميركية، بل لا نغالي إن قلنا إنها باتت تسبقها بخطوات واسعة؛ إذ يتقدم الصينيون بخطى حثيثة؛ ما يرفعهم لمصاف الوسطاء الكبار.
منذ الإعلان عن الاتفاق الأخير، والأقلام الأميركية بنوع خاص، لم تتوقف عن محاولة التحليل والتوصل إلى خلاصات، ومن بين ما لفت الانتباه عبر صحيفة «النيويورك تايمز» الأميركية ذائعة الصيت، القول بأن الأمر، استعلان لمولد «القرن الصيني».
تبدو هنا عقدة القصة، كما يقول كتاب الدراما، فما يشغل واشنطن في حقيقة الحال ليس شكل العلاقة بين الرياض وطهران، ولا مسارتها ومساقاتها، بل كل ما يهمها هو القطبية الدولية الصينية الجديدة، التي استطاعت النجاح فيما أخفقت هي فيه، وهو أمر يهدد فكرة «الاستثنائية الأميركية»، في جانبها الخاص بالقدرة على الوساطة بين الأمم، سيما أن الصين سوف تظهر في أعين العالم صانعة سلام، بينما تتكرس لدى الملايين حول العالم، رؤية عن أميركا البراغماتية بصورة غير مستنيرة، الساعية للدفاع عن موقعها وموضعها كقوة منفردة بمقدرات العالم، حتى ولو كلف الأمر إشعال حروب وتأجيج صراعات، خدمة لمصالحها.
يعنّ لنا أن نتساءل عن تداعيات الوساطة الصينية، وهل هو بالفعل زمن القرن الصيني؟
لا يمكن الجواب بعيداً عن قياس ردات الفعل الأميركية، سيما أن البيت الأبيض كان حذراً إلى حد القلق من التعليق، وكأنهم كانوا يتجنبون الخوض في فرضية تآكل النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط والخليج العربي.
الرئيس الأميركي جو بايدن، وفي رده على صحافي أميركي سأله عن رأيه في الإعلان السعودي - الإيراني الأخير، أجاب بالقول «كلما كانت العلاقة بين إسرائيل وجيرانها العرب جيدة، كان هذا أفضل للجميع».
الجواب يدفعنا في طريق استنتاجات واسعة تبدأ من عند القدرات الذهنية للرئيس، مروراً بما يُعرف بحالة الإنكار عند الإصابة بمرض عضال، وصولاً إلى الرضا النفسي المبطن لما حدث، والسعي للتجاهل حتى وإن كان منافياً أو مجافياً للواقع.
غير أن البعض الآخر في الداخل الأميركي، أدرك على الفور أن العالم تغير وسيتغير، بعد هذا الاختراق الدبلوماسي الصيني الناجح، فعلى سبيل المثال، تحدث السفير الأميركي السابق لدى مصر وإسرائيل، دانيال كيرتز بالقول «إن الديناميكيات المتغيرة التي يمثلها الاتفاق الذي توسطت فيه الصين، لا تزال تشكل تحدياً لإدارة بايدن التي تفضل التركيز في مكان آخر».
يتساءل المراقبون، ومنهم في الداخل الأميركي «لماذا أخفقنا؟».
ببساطة شديدة؛ لأن واشنطن باتت مهمومة، بل محمومة بالصراع الروسي - الأوكراني، ومصممة على هزيمة سيد الكرملين بأي ثمن؛ الأمر الذي ولّد حلفاً روسياً – صينياً، يتنامى ويشتد عوده؛ ما شغلها عن بقية الملفات الملتهبة عالمياً.
ومن ناحية أخرى، فإن خذلان الحلفاء الموثوقين، وتفضيل اللغة الخشبية، عوضاً عن القوة الناعمة، والتنكر لأصدقاء أثبتوا عبر عقود طوال صدقيتهم وإخلاصهم، جعل أكثر مناطق النفوذ الأميركي، مربعات خالية، وإذا كانت قوانين الطبيعة تمقت الفراغ، فإن جيوسياسيات القرن الحادي والعشرين، بدورها تسعى عن عالم الشراكات لا عالم الفوقيات والإملاءات.
هل يقوّض الاتفاق السعودي - الإيراني نفوذ واشنطن في المنطقة؟
يضحى من المغالاة القول بذلك؛ إذ ستظل للولايات المتحدة الأميركية أدوارها المهمة، وما من عاقل ينفي هذه الفرضية أو يتجاهلها.
غير أنه ومن دون أدنى شك، سوف تجد واشنطن نفسها أمام فاعلين آخرين، يمكنهم القيام بدور بنّاء عبر دبلوماسية أكثر فاعلية، لا تورط نفسها في المنافسات، ولا تشغل ذاتها بالتصارع والتنازع، دبلوماسية لا تنحاز انحيازاً أعمى لطرف بعينه، ولا تغزل على المتناقضات لمكايدة ثالث.
أثبتت الصين، وعلى حد تعبير الباحث الأميركي الجنسية الإيراني الأصل تريتا بارسي، أنها جهة فاعلة قادرة على حل النزاعات، وليس فقط الترويج للصفقات، عسكرية كانت أو تجارية.
تبدو بكين اليوم لاعباً عالمياً، على غرار ما كانته في حقب زمنية سابقة من تاريخ العالم؛ ما يطرح علامة استفهام «هل صعود الصين يستدعي عزل بكين أم كبح التعاون معها؟».
هكذا تساءل المستشار الألماني، أولاف شولتز مؤخراً عبر مجلة «الفورين آفيرز» الأميركية.
بالقراءة المحققة والمدققة لاستراتيجية الأمن القومي الأميركي الحديثة والأولى في زمن الرئيس بايدن، نرى توصية تقرّ بأن «هناك حاجة إلى التعامل مع البلدان التي لا تتبنى المؤسسات الديمقراطية، لكنها رغم ذلك تعتمد على نظام دولي قائم على القواعد وتدعمه».
هذا الحديث من غير جهد في التفكيك، يقصد به الصين وروسيا بنوع خاص، وبالإقرار بأن ما قامت به الصين مؤخراً أمر يعزز من استقرار احترام قواعد القانون الدولي، وترجيح الوساطات السلمية، على المواجهات العسكرية، يخلص المرء إلى القول إن الصين أضحت عاملاً معززاً لفكرة عالم متعدد الأقطاب، وأنه على واشنطن البحث في آليات الحوار والتعاون، حتى وإن تطلب الأمر مغادرتها لمنطقة «الراحة الديمقراطية»، التي ألفتها، والتعاطي مع بقية العالم، كما هو، لا كما تريده واشنطن.
هل سيكون للأميركيين دالة على الحكمة في المدى المنظور، وبعد الاتفاق السعودي - الإيراني الأخير؟
الجواب يتطلب مزيداً من الوقت لمتابعة ردات الفعل الأميركية، لكن الرسالة التي وصلت ولا شك لسيد البيت الأبيض، تحمل تأكيداً على أن زمن المعسكر الواحد، الأميركي تحديداً، والاصطفاف من حوله قد ولى، وأن هناك حقبة زمنية من التحالفات اللزجة أو المرنة، تتشكل في الرحم الكوني، انتظاراً لبزوغ نظام عالمي جديد.
GMT 14:38 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
الحضارة بين العلم والفلسفة أو التقنية والإدارةGMT 14:35 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
التسمم بالرصاص وانخفاض ذكاء الطفلGMT 17:39 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
أي تاريخ سوف يكتب؟GMT 17:36 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
لا تَدَعوا «محور الممانعة» ينجح في منع السلام!GMT 17:32 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
عودة ترمبية... من الباب الكبيرالاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
الرباط - المغرب اليوم
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 2028). ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير الم�...المزيدالمغربية فاطمة الزهراء العروسي تكشف عن استعدادها لخوض تجربة جديدة في عالم التمثيل بعد غياب دام لسنوات
الرباط - المغرب اليوم
كشفت الفنانة فاطمة الزهراء العروسي، عن استعدادها لخوض تجربة جديدة في عالم التمثيل، وذلك بعد غياب دام لسنوات.وأوضحت فاطمة الزهراء العروسي، في تصريح أن مشاركتها في هذا العمل الجديد سيكون مفاجئة لجمهورها، حيث ستط...المزيداندلاع حريق ضخم في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية في اليابان
طوكيو - المغرب اليوم
اندلع حريق ضخم صباح اليوم الثلاثاء في موقع تجارب تابع لوكالة الفضاء اليابانية أثناء اختبار صاروخ "إبسيلون إس" الذي يعمل بالوقود الصلب، وفقا لمشاهد بثّتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "إن إتش كيه". وأظ�...المزيدتصنيف المغرب في المرتبة الأولى عالمياً في مجال حفظ القرآن الكريم
الرباط - المغرب اليوم
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن تصنيف المغرب في المرتبة الأولى عالميًا في مجال حفظ القرآن الكريم. يعد هذا التكريم شهادة جديدة على عراقة وتقاليد المغرب في مجال العناية بكتاب الل...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©