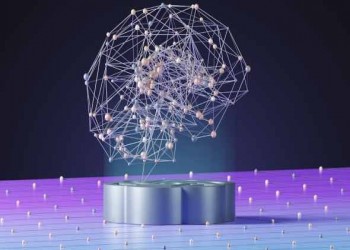الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
ثمن الجائزة الذي لا تريد القارة السمراء أن تدفعه

سليمان جودة
بقلم : سليمان جودة
لا ينافس محمد صلاح الذي يشتهر بأنه مو صلاح، إلا المهندس السوداني البريطاني محمد إبراهيم الذي يشتهر هو الآخر بأنه مو إبراهيم.ولم يشأ مو إبراهيم أن يقصر شهرته على نفسه أو شخصه، فبادر إلى إنشاء مؤسسة تحمل الاسم نفسه وتشتهر به بين الناس، ثم تمنح جائزة في كل سنة لمن تراه يستحقها من بين أبناء القارة السمراء.
نشأت الجائزة في 2005. ومن يومها راحت تمنح جائزتها الضخمة في موعدها من كل سنة، ولم تكن تجد حرجاً في حجب الجائزة في سنوات كثيرة، وكان هذا يحدث إذا رأت أن شروطها لا تنطبق على الذين ترشحوا لها، أو إذا رأت أن الأسماء المطروحة في بورصتها لا ترقى إلى الفوز بها.
وما يميزها عن سواها من الجوائز أنها جائزة لا يحصل عليها آحاد الناس من الأفارقة، وإنما يحصدها الساسة الذين جلسوا ذات يوم في مقاعد الحكم من أبناء القارة، ولكن ليس أي ساسة طبعاً مهما كانت شهرتهم أو سنوات بقائهم على مقاعد السلطة، لأنها لا تذهب إلا إلى السياسي الأفريقي الذي يقدم لبلاده خدمات مذكورة في الصحة، وفي التعليم، وفي الأمن، وفي التنمية، والأهم من هذا كله أن يتخلى هذا السياسي سلمياً وديمقراطياً عن الحكم، فلا يمسك في الكرسي بأسنانه ويديه.
ولا بد أن المهندس إبراهيم يستحق التحية على جائزته من حيث فكرتها، لأنه لم يشأ أن يجعلها في نطاق بلده السودان، ولو فعل ما كان أحد سوف يلومه، بل كان أبناء وطنه سيشكرونه بالتأكيد، ولكنه بدلاً من أن يجعلها جائزة سودانية خالصة، قرر أن يوسع نطاقها وأن يجعلها جائزة أفريقية، وأن يجعل السباق عليها في ملعب يضم 54 دولة، هي دول القارة.
وكأنه وهو يوسع زاوية الجائزة كان يريد أن يقول إن انتماءه إلى السودان لا يمنع انتماءً آخر أوسع يشده إلى القارة كلها، وإنه يريد أن يسعف قارته وألا يخذلها، وإنه لا أحد من أبنائها سوف يسعفها، بقدر ما سوف يسعفها الذي يقدم لها ما يجعل الحكم فيها أرشد، وأقرب إلى العقل منه إلى ما عداه، وأبعد عن التمسك بالسلطة كما بين السماء والأرض.
أما اسم الجائزة فهو جائزة الحكم الرشيد، وهو اسم كما ترى لا يخلو من معنى أراده صاحبها، وهذا المعنى هو أن تسعى الجائزة سنةً من بعد سنة إلى التأسيس لمبادئ الحكم الرشيد في أفريقيا، ربما لأنها القارة التي اشتهرت بتكرار الانقلابات على الحكم في كثير من عواصمها.
وليس الحكم الرشيد إلا أن يأتي الحاكم بإرادة الناس الخالصة، ثم ينصرف بالإرادة نفسها إذا انقضت سنواته في منصبه، ولو حدث هذا فسوف يؤسس مثل هذا الحاكم للرشد في الحكم، وسوف يجد جائزة مو إبراهيم في جيبه، وسوف يعيش مذكوراً بالخير في كل الأوقات، ولا مثال على هذا أوضح من المثال الذي ضربه الجنرال سوار الذهب في الخرطوم.
فلا يزال الرجل نادر الوجود في القارة كلها، ولا يزال مثالاً للجنرال الذي يقدم صالح بلاده على مصلحته، ولا يزال في مقدمة الذين يستحقون أن يقام لهم تمثال في كل ميدان، لأن مقاومة سحر السلطة قضية صعبة للغاية على الذين يصلون إليها، ولكنه قاومها وانتصر عليها، وكأنه أراد أن يقول للقادمين من بعده في بلاده وفي سواها من البلاد الأفريقية إن مقاومة سحر الكرسي مسألة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، وإن حالته تظل دليلاً على ذلك في كل وقت، لأنها حالة حية وعملية وليست حالة نظرية.
ومن شدة الرغبة لدى مو إبراهيم في إنجاح جائزته، وفي الوصول بها إلى مستحقيها، جعل قيمتها المادية غير مسبوقة في العالم كله، وليس في القارة الأفريقية وحدها.
بل إنها تتجاوز جائزة نوبل بجلالة قدرها، لأن قيمة نوبل لا تزال في حدود المليون دولار، أما جائزة الحكم الرشيد فهي 5 ملايين، وهي كافية من حيث قيمتها لإغراء كل حاكم في القارة بالسعي إلى أن تكون من نصيبه، أو هكذا نفترض، ولكن يبدو أن مكاسب البقاء في السلطة أكبر كثيراً من الخمسة ملايين دولار، التي تصورها صاحب الجائزة قادرة على الإغراء السياسي، إذا صح التعبير.
ولا شك في أن رصد جائزة بهذا المسمى، وبهذه القيمة المادية، دليل لا تخطئه العين على أن النضج السياسي في القارة السمراء لم يصل إلى مستواه الطبيعي بعد.
وهي دليل على ذلك، لأن التخلي عن الحكم ديمقراطياً قضية ليست في حاجة إلى جائزة نرصدها لمن يبادر فيتخلى، ولأن ترك الكرسي ديمقراطياً لا يستحق أن تخصص له مؤسسة هذا المبلغ الضخم، فالمؤسسة صاحبة الجائزة تلوّح بها من عام إلى عام، وهي تراهن على أن يقتنع الذين يصلون إلى كراسي السلطة في القارة، بأن ينصرفوا من تلقاء أنفسهم إلى حال سبيلهم إذا جاء أوان المغادرة، وبأنهم إذا فعلوا سيجدون مكافأة الجائزة المادية الكبرى في انتظارهم، فضلاً عن عائدها المعنوي المؤكد.
ومن الواضح من تجربة السنوات التي مرت من ساعة رصد الجائزة إلى اليوم، أن هذه القارة المسكينة أمامها وقت غير قصير لتتخلص خلاله من آفة الانقلاب على الجالس في مقعد الحكم، لعلها تصبح في مثل حال القارة العجوز على الشاطئ الآخر من المتوسط، لأنه ما أبعد المسافة بين القارتين في هذا الأمر، رغم أنهما يشتركان في الإطلالة على بحر واحد.
والقضية تظل في حاجة إلى تراكم عبر السنين، وفي حاجة إلى تجارب في الحكم يأخذ بعضها من بعض، لأن القارة الأوروبية لم تصل إلى ما وصلت إليه بين يوم وليلة، ولم تجد نضجها السياسي على قارعة الطريق، ولا كان هذا النضج نبتاً شيطانياً، ولكنها مسيرة يتربى فيها الناس على ممارسات وسلوكيات، ويلتزمون بها تلقائياً، ولا يخرجون عليها مهما كانت الإغراءات.
وفي السنة الماضية، ضبطت الحكومة الألمانية جماعة متطرفة، كانت تجهز للانقلاب على الحكومة، وقد بدت نشازاً في القارة كلها، وليس بين الألمان وحدهم، وبدت جملة خارج السياق كله، وسرعان ما طوتها الأحداث ونسيها الناس.
وقد بدت في حينها وكأنها نكتة أو مزحة، لأن أوروبا تعرف أنها ودعت من زمان ما كانت الجماعة تفكر فيه، ولأن الأوروبيين حاولوا عند ضبطها أن يتذكروا آخر مرة وقعت فيها عندهم محاولة للانقلاب على الحكم فلم يفلحوا، لأن المسافة الزمنية بينهم وبين آخر محاولة بعيدة وتكاد تستعصي على الحضور في الذاكرة.
ولكن الحال مع أفريقيا أمر آخر، وليس الواحد منا في حاجة إلى أي جهد يتذكر به على أرضها، ما لم تسعف الذاكرة أهل أوروبا فيه!
وربما لهذا السبب يبدو مشوار مؤسسة مو إبراهيم طويلاً، ولا تستطيع إلا أن تشفق على صاحب المؤسسة، وهو يحاول ترويض مؤسسات الحكم في القارة، ثم وهو يرصد الكثير من المال لهذا الغرض، فلا يملك من جانبه إلا أن يحجب جائزته في كثير من المرات، ولسان حاله يردد ما كان الشاعر يقوله عن أن العزم قد صح منه وعن أن الدهر قد أبى.
وقد صح عزم الرجل في جائزته، ولكن أفريقيا أبت، أو إنها تأبى إلا أن تأبى الجائزة، لأن لها ثمناً لا بد أن تدفعه القارة السمراء مقدماً!
GMT 14:15 2024 الأربعاء ,15 أيار / مايو
في ذكرى النكبة..”إسرائيل تلفظ أنفاسها”!GMT 12:08 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
مشعل الكويت وأملهاGMT 12:02 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
بقاء السوريين في لبنان... ومشروع الفتنةGMT 11:53 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
“النطنطة” بين الموالاة والمعارضة !GMT 11:48 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
نتنياهو و«حماس»... إدامة الصراع وتعميقه؟وزير الاستثمار المغربي يكشف عن استفادة 48 مشروعاً من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية
الرباط - المغرب اليوم
كشف كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن استفادة 48 مشروعا من المنحة الترابية المخصصة للاستثمارات في الأقاليم التي تعاني نقصا في التنمية. وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الش�...المزيدالمغربية سميرة سعيد تسّتعيد ذكريات طفولتها وشغف البدايات بفيديو نادر
الرباط - المغرب اليوم
فاجأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، جمهورها بمقطع فيديو نادر، ظهرت خلاله وهي طفلة تغني على المسرح مُنذ أكثر من 50 عاماً، أغنية "كيفاش تلاقينا".وقالت سميرة سعيد، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام: "كلّما أشاهد ن�...المزيدشركة ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستغرام
واشنطن - المغرب اليوم
تعتزم شركة "ميتا" إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي.وجاء في تقرير لصحيفة (فاينانشال تايمز) أن الشركة تعتزم، لكي تحافظ على قاعدة مست...المزيدوزير الثقافة المغربي يسّتعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث
الرباط - المغرب اليوم
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن من ضمن مرامي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي. وأبرز الوزير لدى تقديم مض...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©