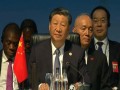الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
لحظة الرياض وقمة إدارة الاختلاف

مأمون فندي
بقلم : مأمون فندي
الدبلوماسية أساسها التفاوض والمساومات من أجل تعظيم مكانة الدولة ومصالحها
نضج أي دبلوماسية يُقاس بقدرة الدولة على إدارة مساحات الاتفاق والاختلاف بين الدول، ولكن إدارة الاختلاف والاتفاق بين قوة إقليمية ودول عظمى، مثل الخمس الكبار هي ما تراه اليوم في قمم المملكة العربية السعودية باختلافاتها؛ من القمة الإسلامية - الأميركية، في فترة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى القمة العربية - الصينية، إلى القمة العربية التي حدثت في جدة، الأسبوع الماضي، والتي عادت فيها سوريا إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية، رغم اعتراض الولايات المتحدة وتحذيراتها، وتحدث فيها الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
وكان من قبل هذا كله الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية صينية، لإعادة العلاقات بين البلدين، التي أيضاً لها فاتورة أميركية. كيف استطاعت المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وإدارة الأمير محمد بن سلمان أن تدير مساحات الاتفاق والاختلاف بين المملكة والقوى العظمى. هذا يفسر أننا مع حالة سعودية جديدة وسياسة خارجية بها كثير من المرونة والثقة بالدولة وقدراتها. الدبلوماسية أساسها التفاوض والمساومات من أجل تعظيم مكانة الدولة ومصالحها والبحث عن مساحات الاتفاق وسط مساحات من الاختلاف والصراع لإيجاد حلول مبتكرة تساعد على بناء علاقات سياسية واقتصادية وثقافية بين الدول تسهم في بناء الأمن والسلم العالميين.
في السابق كان يُنظر إلى المملكة من منظور مكانتها الروحية بوصفها مهداً للإسلام، والقائمة على خدمة زوار الحرمين الشريفين، وبالتالي لها ثقلها في العالم الإسلامي، وأن تحالفاتها مع الدول الإسلامية واحدة من أوراق القوة لديها. كان أيضاً يُنظر إليها على أنها دولة نفطية كبرى، كما أنها مهد العروبة، ولديها ثقل وتحالفات عربية تجعل منها قوة شرق أوسطية إقليمية. بمعنى آخر، كانت مركز الثقل الاقتصادي والإسلامي في المنطقة. أما اليوم، فالمملكة العربية السعودية يُنظر إليها من منظور ثقلها السياسي أيضاً سواء فيما يخص دورها في السودان، كما رأينا في حالة اتفاق جدة الذي رعته كل من الولايات المتحدة والسعودية، أو من قبل حل الأزمة الخليجية في «مؤتمر العلا»، وعودة قطر وإنهاء مقاطعتها.
فهل كانت «قمة جدة» تتويجاً لانتقال مركز الثقل الدبلوماسي العربي إلى المملكة؟
لا يفكر السعوديون بهذه الطريقة، ولا أظنهم يبحثون عن الانتقاص من دور لدول شقيقة أو جارة، ولكن هكذا جرت الأمور، وهكذا هي قوانين العلاقات الدولية.
المملكة اليوم لاعب كبير على مسرح الأحداث في الشرق الأوسط، تلك المساحة التي كانت محط أطماع القوى العظمى منذ بداية القرن العشرين. دور الدول العظمى في الشرق الأوسط، خصوصاً أميركا وروسيا، ومن بعد ذلك الصين أمر مفروغ منه، ولكن إدارة التفاوض وإدارة الشراكات مع هذه الدول بما يحقق مصالح المنطقة هو ما تفعله المملكة اليوم دونما صدامات أو عنتريات.
من قبل، حدثت أزمة بين المملكة العربية السعودية وكندا، وكانت للمملكة عقود سلاح ودبابات مع كندا. لم تتشنج المملكة، بل طلبت إعادة طلابها، خصوصاً الأطباء، من كندا إلى المملكة. والذين لا يعرفون، كان الطلاب السعوديون يملأون مستشفيات كندا باعتبارهم طلاب امتياز، وخروج هذه الآلاف من النظام الصحي الكندي كان يمكن أن يتسبب في كارثة. ولم تطلب السعودية إلغاء الصفقة العسكرية مع كندا، فقط طالبتها بدفع الشرط الجزائي، وتراجعت كندا، ولم تلجأ المملكة إلى العنتريات في تلك المواجهة.
إذن، نحن أمام دبلوماسية ناضجة ومرنة وواثقة تعرف أبعاد قوتها بوصفها قوةً إقليميةً، ومدى الدعم التي تحظى به في العالمين العربي والإسلامي، مما يساعدها على أن تستضيف زيلينسكي والأسد في قمة واحدة، لأنها واثقة من أن ذلك هو الطريق نحو حلحلة النزاعات، وذلك لأنها قادرة على إدارة مساحات الاختلاف مع الدول العظمى، وأيضاً قادرة على الحفاظ على مساحات الاتفاق، التي هي رصيد قوة المملكة عالمياً.
«قمة جدة» عكست لنا سعودية لم نكن نعرفها من قبل. أظهرت لنا قوة دولة إقليمية، ووضحت أيضاً أننا أمام خط بياني متصاعد لقوة هذه الدولة. مهم للعالم العربي أن يكون له مركز ثقل، ويبدو أن العالم العربي اتفق تقريباً على أننا نعيش لحظة الرياض.
GMT 14:35 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
التسمم بالرصاص وانخفاض ذكاء الطفلGMT 17:39 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
أي تاريخ سوف يكتب؟GMT 17:36 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
لا تَدَعوا «محور الممانعة» ينجح في منع السلام!GMT 17:32 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
عودة ترمبية... من الباب الكبيرGMT 17:27 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
ترمب الثانيوزارة الإقتصاد والمالية المغربية تعلن إرتفاع المداخيل الضريبة بنسبة 12,5 في المائة
الرباط - المغرب اليوم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أ�...المزيدرافائيل نادال يختتم مشواره ويلعب مباراته الأخيرة في كأس ديفيز 2024
لندن - المغرب اليوم
يشارك لاعب التنس الإسباني الشهير " بطولة رافائيل نادال " في التنس الأخيرة في مسيرته الرائعة هذا الأسبوع، حيث سيمثل بلاده في كأس ديفيز 2024. يعتبر الإسباني البالغ من العمر 38 عاما، والذي يحتل المركز الثاني بعد " ...المزيدميركل تحذّر و تعبّر عن قلقها من سيطرة ماسك على 60% من الأقمار الصناعية
برلين - روان محمود
بعد كشفها عن تفاصيل لقاءاتها السابقة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال مقتطفات من مذكراتها التي ستصدر الأسبوع المقبل، أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن قلقها على النظام الديمقراطي مع ...المزيدالحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الذي قدمه وزير الشباب والثقافة
الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح بلاغ للوزا...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©