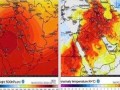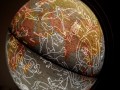الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
عبء الرجل العربي... وجهة نظر

مأمون فندي
بقلم : مأمون فندي
عبء الرجل الغربي؛ تلك النظرية التي سادت في الغرب في القرن التاسع عشر ترى أن الاستعمار كان ضرورة لتمدُّن الشعوب المتخلفة وتحضرها، وعلى الرجل الغربي أن يحتل هذه البلدان كي يمدنَها ويدخلَها في ركب الحضارة، وكان ذلك تبرير الغرب للهيمنة والاستعمار في أفريقيا وآسيا.
عبء الرجل الغربي منح الاستعمار بُعداً أخلاقياً يقول إن على الرجل الأوروبي أن يتحمل كل هذه المتاعب والصعاب من أجل أن ينقل أهالي المستعمرات من حالتهم البدائية إلى حالة مدنية.
كنتُ أتخيل الرجل الغربي رسماً كاريكاتورياً محمّلاً بهذا العبء الذي يكاد يقصم ظهره، كلما قرأتُ نصاً يتحدث عن عبء الرجل الغربي أيام الصبا، وكنت أقول في نفسي: لماذا لا يلقي هذا الحمل الثقيل، وينصرف إلى حال سبيله، ويستمتع بحياته، لماذا كل هذا الحمل؟ إلى هنا ينتهي حديثي عن عبء الرجل الغربي، لأنتقل إلى الحديث عن عبء الرجل العربي، خصوصاً فيما يتعلق بفلسطين وما رآه الرجل العربي منذ عام 1948 على أنه حمله الذي يجب أن يضعه على ظهره، وبالفعل البعض فعل، خصوصاً خلال فترة طويلة ربما انتهت مع زيارة الرئيس السادات لإسرائيل، وتوقيع «اتفاق كامب ديفيد» عام 1979.
ألقى السادات وكثيرون معه هذا الحمل الثقيل مِن على ظهورهم، ولذلك بدا السادات ممشوقاً وهو ينزل من الطائرة، مرفوع القامة يمشي، وقادة إسرائيل كلهم في استقباله؛ من غولدا مائير إلى مناحم بيغن إلى رابين وبيريز وغيرهم، وكان السادات أول الغيث. والقصة هنا ليست نقداً لسياسات دول ترى أن مصلحتها أن يكون بيننا وبين إسرائيل سلام، أساس القصة ذلك التناقض بين إعلام سياسة مستقلة، وهذا حق، وإعلان الرجل العربي في الوقت ذاته أنه ما زال يحمل عبء فلسطين، بما في ذلك السادات ذاته، الذي كان يعلن ذلك حتى وفاته. وهنا يتضح الفارق بين حِمل الرجل الغربي المعلن، الذي كان ينفذ على الأرض بدأب وإخلاص، رغم أنه أكذوبة كبرى، وحِمل الرجل العربي الصادق الذي لم يتورع عن التخلي عنه عند أقرب مفرق على الطريق. فعل ذلك في الواقع ومع ذلك نسمع صوته القادم من بعيد وأنينه، نتيجة إعلانه أنه ينوء بما يحمل.
المتابع لخطابنا المكتوب والمتلفز حتى على حسابات «التيك توك» لا تفوته ملاحظة أننا اليوم جميعنا نتململ من عبء الرجل العربي، ونريد أن نلقيه خلف ظهورنا، مشكلتنا ليست التخلي الأخلاقي عن هذا العبء الصادق، ولكن البحث عن ذرائع تبرر سلوكنا. نؤلف القصص التي لا تصلح حتى قصصَ ما قبل النوم لأطفال دون العاشرة؛ قصصاً كثيرة نختلقها لتبرير إلقاء هذا الحمل على قارعة الطريق. مرة نقول إنَّ «الفلسطينيين قد خانوا قضيتهم»؛ فلماذا نحملها نحن؟ ومرة ندعي أن الموضوع برمته كذبة كبرى، مثلما قال صدام، حسبنا أنه يريد تحرير القدس عن طريق الكويت، أو أن الطريق للقدس بالنسبة لإيران يمر عبر دمشق وبيروت وصنعاء وبغداد. ولكنني لا أتحدث هنا عن عبء الرجل الإيراني؛ فذلك صليبه يعلقه في رقبته كما يشاء. أنا أتحدث عن عبء الرجل العربي. يدهشني في أحاديثنا وكتاباتنا هذه الأيام تلك الذرائع الكثيرة التي يتبناها البعض ليبرر أن يلقي حملاً هو ليس حامله أصلاً، على أول ناصية، ويبتغي ألا يلومه أحد، أو أن يصفق البعض لجرأته على إعلانه أنه لا يستطيع الاستمرار في الحياة وهو يحمل كل هذا العبء الفلسطيني. ومتى كنا نحمله كي يلقيه؟ فقد كانت فلسطين بالنسبة لكثير منا عصا نتوكأ عليها، وعندما قيل لنا: «ألقها»، لم نتورع للحظة في التخلص منها.
أكتب هذا لأسباب كثيرة، ولا أدعي تفوقاً أخلاقياً وأنا أخط هذه الكلمات، بل أحس بالخجل الشديد وأنا أشاهد الحالة التي تمر علينا هذه الأيام، وبدلاً من مناقشتها بحزم وتحمل، على الأقل مسؤولية الجدة في الحوار حول فلسطين، قررنا أن نتخلى عن عبء الرجل العربي كله، ونحن نحتفل بجرأتنا في الإعلان عن حالة التخلي عن المسؤولية هذه. التخلي عن عبء الرجل العربي لا يشبه التمسك بعبء الرجل الغربي، رغم وجود المبرر الأخلاقي للأول، وعدم وجوده بالنسبة للثاني. الرغبة في التخلي عن عبء الرجل العربي توغلت في النفوس، ليس خارج فلسطين، بل تدعي أنه توغل حتى في الأراضي المحتلة ذاتها. الأمر يحتاج إلى نقاش ناضج وهادئ، ليس بقصد اللوم أو التقريع، ولكن بهدف أن نواجه أنفسنا بلحظة الحقيقة. وكان نقدي لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل لا يخص السلام كفكرة في حد ذاتها، ولكن من باب أن ذهنية الادعاء جعلتنا نقبل بسلام كان من الممكن أن نحصل على سلام أفضل منه، وما ينطبق على مصر ينسحب على غيرها، ولكن، وفي النهاية، شتان بين حلم الرجل الغربي وحلم الرجل العربي.
GMT 17:39 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
أي تاريخ سوف يكتب؟GMT 17:36 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
لا تَدَعوا «محور الممانعة» ينجح في منع السلام!GMT 17:32 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
عودة ترمبية... من الباب الكبيرGMT 17:27 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
ترمب الثانيGMT 21:28 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
«هي لأ مش هي»!وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية تُؤكد أن نسبة التضخم انخفضت إلى 1.1 في المائة
الرباط - المغرب اليوم
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إن نسبة التضخم انخفضت إلى 1.1 في المائة، مؤكدة أن التغطية الصحية واقع وحقيقة يستفيد منها المغاربة والحكومة لم تقل أن أبدا إن هذا الورش انتهى. وأشارت خلال مناقشة الجزء ا�...المزيدمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُكرّم "الفتى الوسيم" أحمد عز عن مجمل مشواره الفني
القاهرة - المغرب اليوم
تم الإعلان عن تكريم الفنان أحمد عز بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي تنطلق فعالياته بدءاُ من اليوم وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويأتي تكريم الفنان أحمد عز بعد سنوات من الإبداع الفني ت�...المزيدالذكاء الاصطناعي يساهم في انبعاثات ضارة تؤثر سلباً على البيئة
بكين - المغرب اليوم
قالت دراسة علمية جديدة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تخلق انبعاثات هائلة تضر بالبيئة بشكل كبير.ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد حذرت الدراسة من أن الطاقة المتزايدة المطلوبة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء �...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©