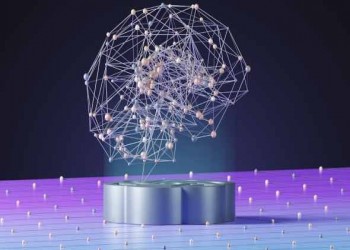الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الحدود البحرية بين المقاومة والدولة

محمد عبيد
بقلم : محمد عبيد
أسئلة كثيرة أثارها ويثيرها كل يوم ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية، وفي مقدمة هذه الأسئلة الوقائع المريبة والمشبوهة التي حكمت أداء الدولة اللبنانية منذ بداية البحث في هذا الملف، ومثال ذلك:
أولاً: في 1/3/2009 قامت حكومة العدو بترسيم حدود البلوكات الخاصة بها، وبعد حوالى شهرين أي بتاريخ 29/4/2009 قامت الحكومة اللبنانية باعتماد الخط 23 على حدود البلوكات الإسرائيلية تماماً بعد ترسيم من جانب واحد بالتوازي مع ترسيم آخر أقرّته مع سوريا وقبرص. هل هي مجرد صدفة؟!
ثانياً: في العام 2010 أودعت الحكومة اللبنانية إحداثيات الخط 23 لدى دوائر الأمم المتحدة، وذلك قبل عام من صدور المرسوم 6433 أي بتاريخ 1/10/2011؟!
ثالثاً: في شهر آب 2011 صدر تقرير مكتب الهيدروغرافيا البريطاني (UKHO) الذي أكد أن خط الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية هو الخط 29، وبعد حصول قيادة الجيش اللبناني على هذا التقرير في العام 2013، أرسلته الى وزارة الأشغال والنقل وعبرها الى رئاسة الحكومة التي أودعته في جواريرها وأحكمت الإقفال عليه؟!
رابعاً: في العام 2018 أنشأت قيادة الجيش مصلحة الهيدروغرافيا وبدأت بتدريب المتخصصين من ضباطها في هذا المجال، ودام ذلك حوالى عامين الى أن عاودت إرسال الدراسة المتعلقة بالخط 29 مرة جديدة الى رئاسة الحكومة، التي أودعتها مجدداً في جواريرها وأحكمت الإقفال عليه؟!
هي بعض الأسئلة وليست كلها والتي تشير بما لا يقبل الشك الى أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة وأصحاب القرار في مفاصل الدولة كانوا يتعمدون عن سابق إصرار وتصميم إخفاء أي معلومات يمكن أن تؤدي الى تحسين شروط لبنان في التفاوض المباشر الذي عمل عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الجانب الأميركي والذي كان وما زال يدور بين الخط الإسرائيلي المودع لدى الأمم المتحدة في شهر تموز 2011 ويحمل الرقم 1 وبين الخط اللبناني 23 أي في مدار ما سُمي خط «هوف»، أو التفاوض غير المباشر الذي تعتمده الدولة اللبنانية حالياً من خلال الحركة المكوكية التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، والتي يضبط إيقاعها وفقاً للوقائع السياسية الإسرائيلية الداخلية!
وهي ليست المرة الأولى التي تسقط فيه هذه الدولة الفاشلة والفاسدة في امتحان الحفاظ على حقوق لبنان السيادية وثرواتها الطبيعية، ولِمَ الاستغراب وسلطة هذه الدولة فشلت في الحفاظ على الدولة نفسها وعلى مؤسساتها وإداراتها وسرقت ممتلكاتها العامة البحرية والبرية ونهبت مالها العام وأموال الناس، وبعد ذلك كله المطلوب منا اليوم أن نصدق أن هذه الدولة بأركانها أنفسهم قادرة على حماية ثروات لبنان من النفط والغاز الكامنة في مياهه!
على أن المقاربة الأهم التي تستوجب الانتباه إليها بل الوقوف عندها بتمعن ودقة هي التالية: ونحن في زمن انتصار تموز الإلهي المُطَرز ببطولات وتضحيات اللبنانيين كافة وخصوصاً منهم رجال المقاومة وقادتها، لا بد أن نستذكر سلوك الدولة اللبنانية السياسي تجاه مواقف المقاومة وأدائها، وبالأخص عدم قدرتها على استيعاب حجم هذا الانتصار وتداعياته الإقليمية والدولية، وبالتالي السعي الى الاستفادة من تلك التداعيات انطلاقاً من اعتبارها تعديلاً في موازين القوى لصالح لبنان في مواجهة صَلَف الإدارة الأميركية آنذاك واستهانة العدو الإسرائيلي بالقدرات العسكرية للمقاومة، إضافة الى نكرانه أن نجاح قيادة المقاومة في إدارة السيطرة والتحكم في الحرب، أفقدته عنصر المباغتة وبالتالي القدرة على تحديد النهاية المفترضة التي تمناها لهذه الحرب.
لذلك كانت الدولة اللبنانية بأركانها كافة تفاوض تحت سقف استدرار تعاطفٍ مبتذل من الإدارة الأميركية، في حين كانت تلك الإدارة تعمل على احتواء تداعيات ذلك الانتصار ومحاولة تفريغه من معانيه السياسية والمعنوية، وذلك من خلال استصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1701 تُسقط فيه بعضاً من الثوابت اللبنانية المتعلقة بحدوده عبر تضمين هذا القرار عنوان «الخط الأزرق» باعتباره خطاً حدودياً برّياً شبه نهائي وتشكيل لجنة له كبديل عن لجنة متابعة تنفيذ القرار 425 الذي يُثَبِت الحدود الدولية المعترف بها، الى جانب سعي تلك الادارة الى تطويق حركة المقاومة في المساحة الجغرافية التي سُميت بمنطقة الـ1701!
لكن الأهم من ذلك كله أن هذا القرار الدولي الملغوم أدى الى تجميد جبهة الحدود البرية الجنوبية على مدى 16 عاماً حتى الآن، وهو تجميد مرشح للاستمرار في ظل معادلة داخلية وإقليمية ودولية قائمة على توازنٍ ردع يحتاج اختلاله الى متغيرات كبيرة وعميقة في الصراعات الدولية والإقليمية.
هذا على جبهة الحدود البرية، أما مقاربة موضوع الحدود البحرية فهو أمر مختلف تماماً خصوصاً وأن هناك مصالح اقتصادية واستثمارية تتحكم بمسارها وباستقرارها، ذلك ان البعدين الأمني والعسكري لن يكونا سوى عاملين مكملين لجهة حماية تلك المصالح وضمان عمل محطات التنقيب والاستخراج للنفط والغاز من الحقول المعروفة أو المفترضة. مما يعني أن ضمان هدوء جبهة الحدود البحرية الى أجل طويل وطويل جداً هو هدف أساسي لدى المفاوض الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي. وبالتالي فإن قيام الدولة اللبنانية بالتفاوض على بضعة كيلومترات مربعة أو على تبادل رُقَعٍ من حقول مفترضة، يعني أن الغباء في مقاربة هذا المعطى قد استحكم بالدولة اللبنانية أو أن الخوف من العقوبات الأميركية قد تحكم بأركانها الى حد التنازل المُهين!
العدو الإسرائيلي يفاوض على مستقبله الاقتصادي والمالي والاستثماري بل والسياسي على اعتبار أن إنتاجه للنفط والغاز سيفتح له أبواب الكثير من دول العالم. والدولة اللبنانية تفاوض على أملٍ بمحاصصات تطال ثروة لبنان البحرية، وعلى طمع باستثمار سياسي باهت قائم على وعود بازدهار وهمي وحتى لو صار حقيقة فلا يمكن الاستفادة منه قبل سنوات عدة، وعلى جشع أكل الأخضر واليابس من ثروات لبنان وحياة إنسانه ويريد أن يَقبِضَ على منظومة الخدمات اللوجستية التي تحتاجها شركات المسح والتنقيب والاستخراج، وبالتالي لن يستفيد سوى العائلات والحاشيات والمحاسيب والأزلام!
على أي حال، يعلم الإسرائيلي ومعه الأميركي أن الهدوء المستدام على جبهة الحدود البحرية الذي يسعيان إليه يستوجب الحصول على موافقة المقاومة، والمقاومة ليست في وارد أن تمنحهما هذه الهدية إلا في حال حصول لبنان على كامل حقوقه في ثروته البحرية التي حددتها الدولة، الدولة التي تحدثنا آنفاً عنها وعن مستوى أدائها الذي لن يرتقي الى مستوى التحدي المطروح، وهنا تكمن المعضلة. وهذا يقودنا الى سؤال أساسي هو: في حال نفذت قيادة المقاومة تهديدها للعدو، وهو أمر محتمل جداً نتيجة عدم امتثاله للمطالب والحقوق اللبنانية، فهذا يعني أن مواجهة عسكرية ستحصل من الصعب تحديد نهاياتها. ولكن لنفترض أن تدخلات إقليمية ودولية محتملة أوقفت هذه المواجهة عند حدود معينة، هل سيعود لبنان الى التفاوض مجدداً وفقاً للخط 23 المودع لدى الأمم المتحدة؟
وبالتالي ماذا تكون هذه المواجهة قد أكسبت لبنان إذا لم يسبقها تعديل للمرسوم 6433/11، الذي يمنح لبنان قوة في التفاوض بمدى أوسع بكثير يصل الى حدود الخط 29، أي التفاوض على مساحة 1430 كلم2 الواقعة بين الخطين 23 و 29. وقد يصح أن تمنع أية حركة عسكرية تقوم بها المقاومة ضد العدو الإسرائيلي في الاستمرار بإجراءاته لاستخراج النفط والغاز من حقل «كاريش»، لكن ذلك لن يؤدي الى دفع الشركات العالمية الى التقدم لدورات التراخيص التي يمكن أن تطلقها وزارة الطاقة اللبنانية للمسح والتنقيب في البلوكات اللبنانية، كما أنها لن تعالج الأزمات العالقة بين لبنان والشركات الحاصلة أصلاً على حقوق البلوكات الأولى، في حين أن تعديل المرسوم المذكور وإيداعه الأمم المتحدة وإنذار الشركات المعنية بالعمل في حقل «كاريش» بأن استثماراتها في ذاك الحقل تقع ضمن منطقة متنازع عليها كذلك التهديد بمقاضاتها، كل ذلك سيؤدي حكماً الى توقفها عن العمل بانتظار حصول التسوية المفترضة وترسيم حدود المنطقة المتنازع عليها.
مفتاح الحل بيد أركان الدولة، فإما أن يأخذوا لبنان وشعبه الى حربٍ يتحملون وحدهم تبعاتها البشرية والمادية، وإما أن يبادروا الى القيام بواجباتهم الوطنية ومسؤولياتهم الدستورية في معالجة هذه المعضلة سياسياً وديبلوماسياً. وفي حال لم يستجب العدو ومعه الأميركي يتقدم عندها الحل العسكري على كل ما عداه.
ولكن هل يملك هؤلاء الأركان الجرأة للقول لآموس هوكشتاين «لا»؟
(*) المدير العام السابق لوزارة الاعلام
GMT 14:15 2024 الأربعاء ,15 أيار / مايو
في ذكرى النكبة..”إسرائيل تلفظ أنفاسها”!GMT 12:08 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
مشعل الكويت وأملهاGMT 12:02 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
بقاء السوريين في لبنان... ومشروع الفتنةGMT 11:53 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
“النطنطة” بين الموالاة والمعارضة !GMT 11:48 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
نتنياهو و«حماس»... إدامة الصراع وتعميقه؟وزير الاستثمار المغربي يكشف عن استفادة 48 مشروعاً من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية
الرباط - المغرب اليوم
كشف كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن استفادة 48 مشروعا من المنحة الترابية المخصصة للاستثمارات في الأقاليم التي تعاني نقصا في التنمية. وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الش�...المزيدالمغربية سميرة سعيد تسّتعيد ذكريات طفولتها وشغف البدايات بفيديو نادر
الرباط - المغرب اليوم
فاجأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، جمهورها بمقطع فيديو نادر، ظهرت خلاله وهي طفلة تغني على المسرح مُنذ أكثر من 50 عاماً، أغنية "كيفاش تلاقينا".وقالت سميرة سعيد، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام: "كلّما أشاهد ن�...المزيدشركة ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستغرام
واشنطن - المغرب اليوم
تعتزم شركة "ميتا" إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي.وجاء في تقرير لصحيفة (فاينانشال تايمز) أن الشركة تعتزم، لكي تحافظ على قاعدة مست...المزيدوزير الثقافة المغربي يسّتعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث
الرباط - المغرب اليوم
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن من ضمن مرامي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي. وأبرز الوزير لدى تقديم مض...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©