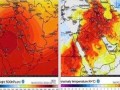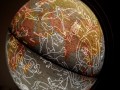الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
... عن عالم بلا هالة

حازم صاغية
بقلم - حازم صاغية
العظيم. العملاق. المعجزة. القامة... وقبل عقود كنّا نقول: «أمير الشعراء» و«أمير البيان» و«العالم العلّامة» و«الفهيم الفهّامة»... فكلّ من يبرز في مهنة أو موقع؛ خصوصاً في الفنّ والإعلام والكتابة، يكون إمّا استثنائيّاً ونادراً وإما مؤسِّساً من صفر وعدم، وهو غالباً ما يُغلق التاريخ وراءه لأنّه شخص غير قابل للتكرار.
هذا القاموس، الذي لا يزال سائداً عربيّاً، يعلن كم أنّنا ماضون في العيش تحت وطأة «الهالة» (the aura). ومفهوم «الهالة» تناولته مقالة طويلة للفيلسوف والناقد الألماني فالتر بنجامين، كُتبت في 1936 بعنوان «العمل الفنّي في عصر إعادة الإنتاج الآليّ»، لتغدو من أهمّ نصوص النقد الفنّي التي أنتجها القرن العشرون.
والحال أنّ فكر بنجامين غالباً ما نُظر إليه بوصفه تقاطعاً بين التقليد الماركسيّ، وهو ما عزّزته صداقته ببرتولت بريخت، والصوفيّة الكاباليّة اليهوديّة التي عزّز تأثّرَه بها صداقتُه الأخرى مع غيرشوم شولم.
لقد جادل بنجامين بأنّ إعادة الإنتاج الآلي لم تغيّر فقط كيفيّات تطوّر الفنّ بل غيّرت أيضاً تعريف الفنّ نفسه. فالإنجازات التقنيّة، التي بدأت في القرن التاسع عشر، تسارعت وتعاظمت ما بين الحربين العالميّتين، شقّاً للأوتوسترادات وعبوراً للأطلسي وانتشاراً تدريجيّاً للراديو والتلفزيون والسينما...
أمّا الهالة فتبثق من مكان آخر يشبه الطبيعة في فرادتها. إنّها كغروب الشمس أو كسلاسل الجبال... والشَبَه هذا بالطبيعة سبق أن عبّرت عنه الموضوعات الفنّيّة حين كانت تتّصل بالسحر وبالمقدّسات والطقوس. ويعطينا بنجامين لمحة عن تاريخ الفنّ، بادئاً برسوم الكهف كأبكر الأعمال التي ولدت لخدمة السحر وطقوسه، قبل تحوّل الفنّ إلى نقل موضوعات الدين وخدمة أغراضه. وحتّى عصر النهضة، الذي جعل العبادة زمنيّة، لم ينجُ من استعراض الأساس الطقسي للعمل الفنّيّ.
لكنْ مع ارتباط الفنّ، بسبب التطوّرات التقنيّة، بإعادة الإنتاج، تولّى مبدأ «الفنّ للفنّ» نقل التقديس والطقوسيّة إلى الفنّ ذاته، فلم تعد هناك حاجة لأي عقلانيّة تسوّغه ما عدا عقلانيّته نفسها. هكذا انطوت السينما والفوتوغرافيا والراديو على عمليّات انفصال عن الطبيعي واقتراب من العلميّ، إذ العمل الفنّي والسينمائي يُقصّ ويُبوّب ويُمنتَج ويوظّف، بينما صار المشاهدون يعبّرون معاً، وكجماهير في بلد واحد أو على مدى العالم، عن انفعالهم بذاك العمل، بدل مشاهدته معزولين في العالم المغلق للبيت.
لقد كانت إحدى الأفكار التي تردّدت في كتابات بنجامين أنّ التصوّرات الإنسانيّة تتغيّر في التاريخ تبعاً لتغيّر التقنيّات، ومن هنا مصدر اهتمامه بالفوتوغرافيا، حيث يمكن تكرار الصور بحيث نفقد كلّ اهتمام بالصورة الأصليّة. فمن نيغاتيف الصورة يمكننا صنع ما لا يُحصى من نسخ، ما يجعل البحث عن النسخة «الأصليّة» و«الأصيلة» جهداً مجّانيّاً بلا جدوى.
فالموناليزا مثلاً، تدرجت منذ رسمها في 1503، من كونها لوحة واحدة صنعها شخص واحد هو ليوناردو، ولم يرها أحد، إلى أخرى يراها حكّام وأثرياء يستطيعون رؤيتها ويحتفظون لها بالكثير من الفرادة وضيق التداول أو الامتلاك. ثمّ كانت المتاحف، ومع إنشاء اللوفر في 1797 نُقلت إليه اللوحة، ما اندرج في دمقرطة الفنّ التي كسرت المراتبيّة إذ أتاحت للجميع رؤيتها. لكنْ بفضل الكاميرا، صار في الوسع تصويرها وامتلاكها وصنع نسخ كثيرة منها تلغي الحاجة إلى زيارة المتحف.
وإذ حرّرت إعادة الإنتاج التقني الفنَّ لأوّل مرّة في التاريخ من الطقسيّات «الطفيليّة»، كانت السينما أكثر ثوريّة من الفوتوغرافيا. ففيها لا يوجد أصل أوّل أصلاً، وبالتالي لا توجد هالة، كما ينعدم الزمان والمكان بحيث يُصوَّر في الاستديو حدثٌ جرى في أبعد زوايا الأرض، كما تفصل بداية الحدث عن نهايته أسابيع من التعطيل وتوقّف التصوير. وبدورهم لا يؤدّي الممثّلون أدوارهم أمام مشاهدين، فيما يتنقّل الفيلم في بلدان العالم دون أي تغيير فيه. ودائماً هناك التحكّم بالزمن إبطاءً وتسريعاً، والتحكّم بالمكان تقريباً وتبعيداً. هكذا تنبّهنا الكاميرا إلى صور ومعانٍ واحتمالات قد تفوت الرؤية الطبيعيّة للعين، فـ«تعرّفنا إلى بصريّات لاواعية مثلما يفعل التحليل النفسي بالدوافع غير الواعية».
وبنجامين لم يكتم حزنه على اختفاء الهالة، تماماً كما يُحزننا اليوم اختفاء القلم لصالح الكومبيوتر، أو قراءة الكتاب على الأون لاين. وهو أقرّ بأنّ الهالة التي تملكها الصورة الأصليّة لا تعوّضها إعادات الإنتاج مهما كانت دقيقة، فيما يؤول تعميم الصورة على شكل نُسخ إلى إضعاف التجربة الإنسانيّة التي تربطنا بالعمل الأصليّ.
مع هذا لم يندرج بنجامين في التشاؤم التاريخي لأرباب مدرسة فرانكفورت (أدورنو وهوركهايمر...) ممن رأوا أنّ الثقافة والإعلام الجماهيريين أحبطا القوى الاقتصاديّة في سعيها إلى التغيير. ويمكن القول إنّ نقده للرأسماليّة وهوليوود لم يحل دون احتفاله بإنجازات إعادة الإنتاج، وبالاحتمالات الجديدة التي يتيحها ضمور الهالة.
لقد تأثّر عاطفيّاً بهذا التطوّر، لكنّه فرح تاريخيّاً وفلسفيّاً، متفائلاً بالثقافة الشعبيّة التي رأى أنّ انقضاء الهالة وانكماش التقاليد قد يطلقان طاقاتها لإتيان عمل ديمقراطي حقيقيّ. فكيف لو أنّه عاش ليشهد إعادات إنتاج متتالية كهربائيّة ثمّ رقميّة؟
إلا أنّ بنجامين لم يعش طويلاً. فبعد أربع سنوات على كتابة هذا النصّ فرّ من ألمانيا التي استولت عليها النازيّة، ثمّ في 1940، انتحر على الحدود الفرنسيّة الإسبانيّة كي لا يقبض عليه النازيّون قبل أن يتمكّن من السفر إلى الولايات المتّحدة.
وما قاله بنجامين يتعدّى الحيّز الفنّيّ. فهو يعلّمنا أنّ كلّ شيء قابل لأن يتكرّر، وأحياناً على نحو أفضل، قبل أن يتقادم ويزول. وهذا شريطة أن يتسارع انفصالنا عن الطبيعة، مع أنّ بعضنا يتباطأون في هذا الانفصال، وبعضنا الآخر يوالي انكفاءه إلى أحضان تلك «الأمّ الحنون».
وأمّا «الأصيل» و«الفريد» فمُجدبان تعريفاً. فهما لا يلدان ولا يتكرّران، إذ بمجرّد أن يلدا أو يتكرّرا لا يعود واحدهما أصيلاً والثاني فريداً.
GMT 17:39 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
أي تاريخ سوف يكتب؟GMT 17:36 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
لا تَدَعوا «محور الممانعة» ينجح في منع السلام!GMT 17:32 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
عودة ترمبية... من الباب الكبيرGMT 17:27 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
ترمب الثانيGMT 21:28 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
«هي لأ مش هي»!نادية فتاح العلوي تؤكد أن الحكومة المغربية متفائلة جداً بشأن النمو الاقتصادي في 2025
الرباط - المغرب اليوم
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في سنة 2025، إذ يتوقع أن يسجل معدل 4.6 في المائة وأوضحت فتاح، أن "هذا الأداء يعزى إلى الدينامية التي تعرفها القطاعا...المزيدمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُكرّم "الفتى الوسيم" أحمد عز عن مجمل مشواره الفني
القاهرة - المغرب اليوم
تم الإعلان عن تكريم الفنان أحمد عز بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي تنطلق فعالياته بدءاُ من اليوم وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويأتي تكريم الفنان أحمد عز بعد سنوات من الإبداع الفني ت�...المزيدالذكاء الاصطناعي يساهم في انبعاثات ضارة تؤثر سلباً على البيئة
بكين - المغرب اليوم
قالت دراسة علمية جديدة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تخلق انبعاثات هائلة تضر بالبيئة بشكل كبير.ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد حذرت الدراسة من أن الطاقة المتزايدة المطلوبة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء �...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©