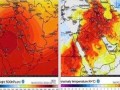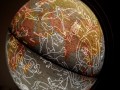الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
حرب «الحقّ» على الحقيقة!

حازم صاغية
حازم صاغية
ليس بلا دلالة أنّ «الحقّ» و«الحقيقة» يملكان، أقلّه في اللغة العربيّة، أصلاً لغويّاً واحداً. مع هذا، فالفوارق بين الاثنين كثيرة. ذاك أنّ الحقّ مفهوم كبير ومجرّد وقد يكون خلافيّاً، يصعب على من يدّعي امتلاكه أن يبرهن ذلك دائماً. و«الحقّ» قد يتشارك فيه مدّعيه مع آخرين يختلفون عنه أو يخاصمونه، لكنّهم هم أيضاً يدّعونه أو يدّعون جزءاً منه. أمّا الحقيقة فحدثٌ ملموس، كبير أو صغير، يصعب أن يقبل سوء التأويل، ويصعب أن يقبل المشاركة بين طرفيه، إذ الجاني واضح والمجنيّ عليه واضح أيضاً. إنّه حدث يمكن أن يُبرهَن وجوده، ويمكن كشفه إذا استتر أو حُجب. وهذا لا يتمّ أساساً عبر الأفكار والسجالات، إذ يلعب البحث والتجريب والتحقيق القضائيّ وجهاز الشرطة الأدوار الكاشفة فيه.
والحقّ ليس بالضرورة جمعاً للحقائق أو مراكمةً لها، لكنّه بالتأكيد ليس نقيضها ولا عدوّها. فحين يغدو الأمر كذلك، نكون أمام مشكلة في حَقّيّة هذا الحقّ، وفي زعم أصحابه أنّه حقّ.
يحصل هذا خصوصاً مع الذين ينسبون إلى أنفسهم امتلاك كلّ حقّ وكلّ الحقّ. وأحياناً لا تكفيهم الحجج الأرضيّة لتعزيز زعمهم فيدّعون النطق بلسان الله كي يمتّنوا دعواهم. هكذا يعيّنون أنفسهم حزباً لله، أو أنصاراً لله فيستدرجون المقدّس إلى ملعبهم.
غير أنّ مسارهم نفسه قد يضعهم في مواجهة كلّ الحقائق: يكذّبونها أو ينفونها أو يزيّفونها أو يقمعونها أو يقتلون العارفين بها منعاً لانكشافها. هؤلاء تعمل الحقائق ضدّ حقّهم، ومَن يكون حالهم كهذا يصعب أن يكون حقّهم حقّاً.
وصِدام «الحقّ» والحقائق في منطقتنا، وفي العالم، قديم نسبيّاً. ودائماً كان «الحقّ» شكّاكاً بالحرّية وبالقضاء وبالأرقام لأنّها كلّها، وبطرق مختلفة، قد تقود إلى الحقيقة. لكنّ الأمور لا تدوم طويلاً هكذا. فبعض ذاك الحقّ المطلق ينقلب ذريعة للطغيان. وبعضه يتجاوزه الزمن. وبعضه تمتحنه التجارب فيرسب في امتحانها... في المقابل، قد يزداد عدد الذين يعرفون أكثر، كما قد يزداد عدد الذين يكتشفون بلحمهم الحيّ أنّ كلفة هذا «الحقّ» عليهم أكبر كثيراً من كلفة عدمه. وأيضاً قد يزيد عدد الذين تضجرهم إعلانات ذاك «الحقّ» التي لم تتغيّر كثيراً منذ الخمسينات. والأهمّ ما قد يتبيّن للكثيرين من أنّ ذاك «الحقّ» مصدر سلطة وارتزاق لدعاة «الحقّ» أنفسهم، لكنّه مصدر إخضاع ونهب لهم.
على العموم، يغدو هذا «الحقّ» بالتدريج نقيضاً للحقيقة، عاجزاً عن التعايش معها، بل يغدو شرطُ استمراره استئصالَ الحقائق ووأدها.
وهناك حالات نموذجيّة باتت معروفة جدّاً في الإصرار القسريّ على نفي التباين بين «الحقّ» والحقيقة. في الأنظمة التوتاليتاريّة مثلاً يستمرّ زعم التوافق بين الحقائق العلميّة وغيرها وبين «الحقّ» الذي تدافع عنه تلك الأنظمة. لهذا تلجأ أنظمة «الحقّ»، قبل أن تسقط، إلى تزوير الحقائق أو فبركتها، وإلى تعميم الكذب، ومعاقبة من يروي مشاهداته أو يقدّم معطيات صلبة يستقيها من الواقع وتناقض ما يقوله «الحقّ». الحقيقة تغدو، وفق تعبير بعثيّ شهير، «إيهاناً لنفسيّة الأمّة». وقد سبق للباحثة الأميركيّة ليزا ويدين أن وصفت الكلام في سوريّا الأسد بمعادلة «كما لو أن»، أي تعالوا نكذب ونتظاهر بأنّنا نصدّق. قبل ويدين، حدّثنا شيزلو ميلوش، الشاعر والروائيّ البولنديّ، في كتابه «العقل الأسير»، عن تحوير الكلام وتزييفه في ظلّ الشيوعيّة البولنديّة، واعتماد «الكتمان» أو التقيّة في تواصل لا يصل أحداً بأحد. قبل أيّام، اقترح علينا الزميل عمر قدّور، ساخراً بالطبع، أن نقول إنّ إسرائيل قتلت لقمان سليم. هكذا نطوي الموضوع ونخنق الحقيقة على النحو الذي يشتهيه أصحاب «الحقّ».
وللبنانيّين تحديداً، كان مدهشاً ما تعلّموه منذ 2005. فبعد اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، ثمّ السياسيّين والإعلاميّين والضبّاط الذين اغتيلوا تباعاً، باتت معرفة الحقيقة مطلب المطالب. لكنْ بعد عام فحسب، وعبر حرب تمّ اقتيادنا إليها، عاد الاستنجاد بـ «الحقّ» لتعطيل الحقيقة: يا لله! إنّ إسرائيل في مواجهتنا ووراءها أميركا، وتريدون معرفة القاتل! المقاومة وُضعت في مقابل القضاء. ما يستحيل التأكّد منه وُضع في مواجهة ما يمكن التأكّد منه. «الحقيقة» الوحيدة المقبولة هي القول إنّ إسرائيل هي التي قتلت الحريري. إنّها ما يطابق «الحقّ». من يقول العكس يبرّئ إسرائيل!
... على مدى سنوات طويلة والحقيقة تعمل عندنا ضدّ «الحقّ». على مدى سنوات طويلة و«الحقّ» يعمل ضدّ الحقيقة. ينكرها. يزوّرها. يخفيها. يقتل حامليها. هذا لا يمكن، على الإطلاق، أن يكون حقّاً.
GMT 06:53 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس
الأميركان.. لا أوفياء وفعلاً أغبياءGMT 06:40 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس
لبنان... بلد الواجهات الحكوميةGMT 06:30 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس
بين فشل أميركا وفشل أفغانستان وفشلنا!GMT 15:46 2021 السبت ,21 آب / أغسطس
دروسٌ طالبانية متعددةُ الاتجاهاتِ ومختلفةُ العناوين "3"GMT 12:27 2021 الجمعة ,20 آب / أغسطس
لبنان الماضي كان افضل... للشيعة أيضانادية فتاح العلوي تؤكد أن الحكومة المغربية متفائلة جداً بشأن النمو الاقتصادي في 2025
الرباط - المغرب اليوم
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في سنة 2025، إذ يتوقع أن يسجل معدل 4.6 في المائة وأوضحت فتاح، أن "هذا الأداء يعزى إلى الدينامية التي تعرفها القطاعا...المزيدمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُكرّم "الفتى الوسيم" أحمد عز عن مجمل مشواره الفني
القاهرة - المغرب اليوم
تم الإعلان عن تكريم الفنان أحمد عز بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي تنطلق فعالياته بدءاُ من اليوم وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويأتي تكريم الفنان أحمد عز بعد سنوات من الإبداع الفني ت�...المزيدالذكاء الاصطناعي يساهم في انبعاثات ضارة تؤثر سلباً على البيئة
بكين - المغرب اليوم
قالت دراسة علمية جديدة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تخلق انبعاثات هائلة تضر بالبيئة بشكل كبير.ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد حذرت الدراسة من أن الطاقة المتزايدة المطلوبة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء �...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©