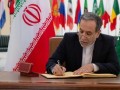الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
المدرسة في أزمة

آمال موسى
د. آمال موسى
لا يختلف اثنان في قيمة التعليم ودوره الحيوي في بناء الإنسان وفي تحصين مستقبل الأوطان من خلال تهيئة الأجيال للذود عنه بالمعرفة والعلم. وعادة ما يرتبط الحديث الرسمي حول التحصيل الدراسي بقياس نسبة التمدرس والأمية في العالم، ومعاينة هذه النسب في ضوء المتغيرات الاجتماعية مثل متغير الجنس مثلاً، وأيضاً علاقة معدل التمدرس بالمستوى الاقتصادي، وعلاقة تلك النسب في تحديد تخلف الدولة من تقدمها.
ولكن يبدو لنا أن هناك مسألة لا نوليها الأهمية والتركيز رغم كونها أصبحت ظاهرة في كل البلدان وفي مختلف المدارس، سواء المدرسة في بلد عربي أو أنموذج المدرسة الفرنسية أو الأميركية. هذه المسألة التي نقصدها هي أن المدرسة اليوم تعاني من أزمة تواصل مع التلميذ ونفور هذا الأخير منها، بل إنّ علاقته بها تقوم على الجبر والحتمية.
طبعاً لا شك في وجود بعض التجارب في عالم المدرسة ناجحة، ولكن الغالب هو وقوع غالبية نماذج المدارس في أزمة حقيقية بدأت تنكشف مظاهرها في توتر العلاقة بين التلميذ والمدرسة، مما أثر على جاذبية هذه المؤسسة الاجتماعية الأولية وعلى وظيفتها الأولى المتمثلة في إيقاع التلاميذ في شغف المعرفة.
إن تلويح بعض الدراسات في علم الاجتماع التربوي عن «أزمة» المؤسسة التربوية، لا يعني أن هذه المؤسسة فقدت دورها في عملية التنشئة والتطبيع الاجتماعيين. فهي تبقى أحد الأمكنة الممتازة لما يسميه ماكس فيبر «قيم التوجيه» وأيضاً ما يطلق عليه بيار بورديو «بناء العقول»، من خلال نظام معرفي قيمي، يهدف إلى تشكيل رأس المال الثقافي للأفراد وأنماط سلوكهم.
يجب ألا ننسى أن المدرسة تهيمن على مرحلتي الطفولة والشباب، ولكنّها ظلت جامدة في تمثلها للتلميذ، ولم تأخذ في عين الاعتبار التغييرات التي عرفتها المجتمعات، وترفض الاعتراف بأن طفل الأمس وشاب الأمس يختلفان كثيراً عن طفل اليوم وشاب اليوم. نفس الامتثالية غير معنية بما قطعته الفردانية من خطوات، مقارنة بالمجتمع التقليدي والمجتمع الذي هبت عليه ريح الحداثة قليلة كانت هذه الريح أو عاتية. لذلك فإن تعالي المدرسة اليوم على هذه التغييرات أدى إلى توتر حقيقي، لكونها لا تعترف بمراهقة التلميذ، ولا تحاول استيعابه والتكيف مع خصوصية هذه المرحلة الصعبة على نفسية المراهق، فهي لا تساعده بقدر ما تدخل معه في مواجهات تنتهي أحياناً إلى القطيعة، وهو ما تعبر عنه نسب الانقطاع المبكر عن الدراسة، الذي لا يعود فقط إلى أسباب مادية، بل إلى أزمة تواصل، خصوصاً أن هذه الظاهرة مستفحلة في التعليم العمومي المجاني. بل إنّ ظاهرة العنف في المدارس بين التلاميذ والأساتذة، هي من أبرز مظاهر أزمة تواصل مدرسة اليوم مع التلاميذ المراهقين، إذ إن المدرسة لا تعترف إلا بالتلميذ الامتثالي والمنضبط في سلوكه، وتمثلاتها للتلميذ ظلت جامدة وصارمة وتقوم على تصور للعلاقة بين الأستاذ والتلميذ تقوم على الهيمنة، وتفتقد إلى المرونة والتفاعل مع الواقع وتغييراته. فالمدرسة في زمنية المجتمع التقليدي، حيث مؤسسات التنشئة الاجتماعية هي المهيمنة على الفرد، من غير الممكن أن تظل بنفس التمثلات، وهي في زمنية مجتمع الفاعل الاجتماعي والفردانية وحقوق الطفل ومزاحمة وسائل التواصل الاجتماعي.
علينا الاعتراف أن تلميذ اليوم لا يشبهنا عندما كنا نحن تلاميذ. فردانيته أعلى منا بكثير، وهي التي تحدد له علاقته بذاته وبالآخرين والمؤسسات. تلميذ اليوم يرفض أن تكون المدرسة هي كل حياته. والمدرسة بجدول أوقات التدريس المكتظ والواجبات المدرسية والامتحانات المتتالية لا تعير لفكرة أن المدرسة ليست كل شيء لطفل وشاب اليوم.
صحيح أن هذه الأزمة تشمل تقريباً كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، حيث أزمة الأسرة وأزمة مؤسسة الزواج... لكن الفرق هو أن مؤسسة المدرسة بحكم أنها مؤسسة المعرفة وتدار من فاعلين معرفيين، فإن ذلك يدعوها أكثر من غيرها من المؤسسات إلى التدبر في أمر أزمتها والمواكبة والمسايرة لتحسن التواصل مع التلميذ. فأي فائدة من التمسك بنفس الأسس التربوية والحاصل أن التحصيل الدراسي في تراجع وبناء العقول أيضاً في تراجع مخيف؟
من المهم أن تفهم مدرسة اليوم في هذا الزمن أن دورها ليس معلوماتياً، بل في بناء العقل وتشكيله على نحو إنساني منفتح يحقق التعايش الإنساني ويضبط علاقة الفرد بغيره على نحو قيمي متسامح ويحتكم إلى القبول واحترام مسافات الاختلاف.
التجربة المدرسية يبدو أنها تفتقر إلى الأبعاد الثلاثة للتجربة التربوية كما حددها فرنسوا ديبي (François Dubet) والمتمثلة في الدخول من خلال الخيال إلى عالم الكبار والمعنى الذاتي الذي يعطيه الفاعل الاجتماعي لتكوينه ولرموز التنشئة المدرسية. أما البعد الثالث للتجربة المدرسية فهو الاستراتيجية، ويقصد بها أنه لا يكفي أن يكون المراهق حاملاً لمشروع أو أنه بصدد تعلم أشياء مفيدة، بل إنه كي تكتسب التجربة المدرسية معنى، لا بد من أن يعرف كيف يحقق أفضل استثمار مدرسي مع أداء «مهنة التلميذ» بشكل مفيد.
يجب أن نفكر في جعل المدرسة بيئة استثمار معرفي وجمالي وذهني للتلميذ، وإلا ستفقد المدرسة وظيفتها مع الوقت. فلا مكان في المستقبل لمؤسسة تقوم في روابطها على العلاقة العمودية وثقافة المؤسسة السلطة التي تفرض الامتثال الآلي.
GMT 06:53 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس
الأميركان.. لا أوفياء وفعلاً أغبياءGMT 06:40 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس
لبنان... بلد الواجهات الحكوميةGMT 06:30 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس
بين فشل أميركا وفشل أفغانستان وفشلنا!GMT 15:46 2021 السبت ,21 آب / أغسطس
دروسٌ طالبانية متعددةُ الاتجاهاتِ ومختلفةُ العناوين "3"GMT 12:27 2021 الجمعة ,20 آب / أغسطس
لبنان الماضي كان افضل... للشيعة أيضايونس السكوري يكشف عن جهود الحكومة المغربية لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة
الرباط - المغرب اليوم
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، الجمعة بمجلس النواب، عن جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025. وأبرز السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة و...المزيدمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُكرّم "الفتى الوسيم" أحمد عز عن مجمل مشواره الفني
القاهرة - المغرب اليوم
تم الإعلان عن تكريم الفنان أحمد عز بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي تنطلق فعالياته بدءاُ من اليوم وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويأتي تكريم الفنان أحمد عز بعد سنوات من الإبداع الفني ت�...المزيدالاتحاد الأوروبي يُغرم شركة ميتا الأميركية بـ800 مليون دولار
واشنطن - المغرب اليوم
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797 مليون يورو (842 مليون دولار) على شركة "ميتا" الأمريكية، المالكة لـ"فيسبوك"، بسبب ممارسات مسيئة في متجر "فيسبوك" الإلكتروني "ماركت بليس".وأصدرت المفوضية الأور...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©