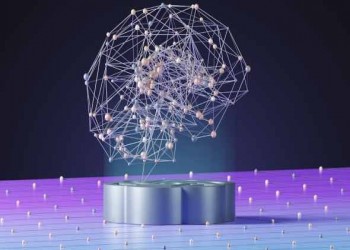الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
العظمة للدم لا للسفارة!

راجح الخوري
الرباط - المغرب اليوم
عندما وصلت صورة «السيلفي» المركبة التي جمعت جاريد كوشنير وزوجته إيفانكا وبنيامين نتنياهو وزوجته، ووراءهم صور الفلسطينيين الذين كانوا يتساقطون بالرصاص الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لم يجد المحرر في موقع «هافينغتون بوست» الإخباري، أفضل من عنوان يقول: «يرقصون على جثث الفلسطينيين». وفي الواقع لم يكن في هذا الوصف أي مبالغة في التعامل مع أيام الدم الفلسطيني المسفوح، فالعالم في التنديد والاستهوال، والإدارة الأميركية في الإشادة!
كانت حصيلة يومي الاثنين والثلاثاء بداية الأسبوع، أكثر من سبعين قتيلاً و2500 جريح، سقطوا على الشريط الشائك عند الحدود، ولم يكن معهم سوى الحجارة يلقونها وإطارات المطاط يحرقونها، احتجاجاً على الاحتفال بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، الذي صادف الذكرى السبعين للنكبة، وهو ما لم يكن يعني تعميق جروح الفلسطينيين والمسيحيين والمسلمين فحسب؛ بل دفن التسوية السلمية، التي يجمع العالم على أن القدس هي مفتاحها، ودفن قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، التي دعت دائماً إلى حل يقوم على مبدأ الدولتين، وانسحاب إسرائيل إلى حدود 1967، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية!
كل ما كان يفعله الفلسطينيون أنهم تجمعوا وتظاهروا، وألقوا الحجارة، وأحرقوا الإطارات احتجاجاً، و«كل» ما فعله جنود الاحتلال الإسرائيلي أنهم أطلقوا عليهم النار، فسقط هذا العدد المخيف من القتلى والجرحى. ولكن في حين غرق العالم بأسره في الصدمة والإدانة، لم يجد صهر الرئيس دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنير، الذي حضر مع زوجته الاحتفال، سوى القول: «إن الذين يتسببون بأعمال العنف هم جزء من المشكلة وليس الحل»!
ولكن ماذا عن الذين يمعنون في القتل وإعدام التسوية السلمية؟ وكيف استطاعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن تتعامى عن جثث القتلى الفلسطينيين، وبينهم عدد كبير من الأطفال، وتقف في مجلس الأمن لتشيد بإسرائيل «لضبط النفس ضد حركة حماس»؟
ضبط النفس! قتل أكثر من مائة وعشرين فلسطينياً، وجرح ما يقرب من ثلاثة آلاف، منذ انطلاق «مسيرة العودة» نهاية مارس (آذار) الماضي، يسمى ضبطاً للنفس! فهل المطلوب تنفيذ هولوكوست فلسطيني، كي يصبح الأمر جريمة تستحق الإدانة التي يجمع العالم على توجيهها إلى إسرائيل؟
لن يسمع الرئيس ترمب باسم ليلى الغندور، الرضيعة ابنة الأشهر الثمانية التي استشهدت يوم الثلاثاء الماضي بالغاز الإسرائيلي، ولن يسمع قطعاً باسم الطبيب الفلسطيني معتصم النونو الذي كان يسعف الجرحى في المستشفى، ثم جاءوا بجثة أخيه معتز قتيلاً ووضعوها بين يديه، ولن يسمع بسقوط أكثر من عشرين شاباً لا تزيد أعمارهم عن عشرين عاماً، سقطوا بالرصاص الإسرائيلي ويتحدثون عن «ضبط النفس»، وذلك «اليوم العظيم لإسرائيل»، يوم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، الذي سيذكر التاريخ أنه اليوم الذي قامت فيه السفارة على بركة من دماء الفلسطينيين، وطبعاً على جثة التسوية السلمية، التي يقول مساعدو ترمب إنها ما زالت ممكنة!
كيف استطاع ترمب أن يتحدث عن العظمة واليوم العظيم، بدلاً من أن يتحسس ملامح الفظاعة واليوم الفظيع في القتل، على الأقل كما أجمع المسؤولون في العالم كله؟ وكيف تمكنت نيكي هيلي من أن تنسحب من جلسة مجلس الأمن أثناء إلقاء السفير الفلسطيني رياض منصور كلمته، لمجرّد أنه حمّل الولايات المتحدة مسؤولية حماية الجرائم الإسرائيلية، وإطلاق الاتهامات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ومخالفة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن، بنقل سفارتها إلى أرض محتلة في القدس، ما يجعل منها مقبرة للتسوية السلمية؟
هيلي لم تتردد في اتهام الفلسطينيين باستخدام الأطفال دروعاً بشرية في المظاهرات ضد نقل السفارة؛ لكنها مجرد مظاهرات وإلقاء حجارة تواجه الرصاص الحي، وهي تتحدث عن دروع بشرية، وهو ما جعل السفير الفلسطيني يصف هذا الموقف بأنه شكل من أشكال العنصرية «لأننا لسنا الاستثناء»، متسائلاً: لماذا يشارك الأطفال الأميركيون مثلاً في مظاهرة واشنطن التي جمعت نصف مليون متظاهر ضد استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة؟
لكن السفيرة الأميركية لم تكتفِ بتعطيل قدرة مجلس الأمن على إجراء أي تحقيق كان قد دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، وبقية الأعضاء الأربعة عشر في مجلس الأمن، الذي عقد بناء على طلب من الكويت، مطالباً بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ بل كانت قد عطلت أيضاً مشروع القرار الأول، وفيه أن مجلس الأمن يعبّر عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ويدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من تفاقم الوضع، بما في ذلك أي تدابير أحادية وغير قانونية تقوّض احتمالات السلام.
وفي إدانة ضمنية لقرار ترمب نقل السفارة إلى القدس، جاء في نص مشروع القرار الذي عطّلته هيلي، أن أي قرارات أو أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تغيير طابع أو وضع التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس، ليس لها أي أثر قانوني. وهكذا لم تكتفِ الإدارة الأميركية بتعطيل مشروع القرار والدعوة إلى قيام تحقيق وتأمين حماية دولية للفلسطينيين؛ بل واصلت الحديث عن أن كل ما حصل ويحصل منذ قرار نقل السفارة لن يعطل فرص التسوية السلمية!
غريب، بعدما اعتبرت السلطة الفلسطينية بلسان الرئيس محمود عباس أن أميركا لم تعد وسيطاً مقبولاً للسلام، وفي حين يصطبغ احتفال نقل السفارة بدماء الفلسطينيين، لم تتردد إدارة ترمب في إعلان أنها قادرة على دفع عملية السلام. وفي السياق قال مايك بومبيو لشبكة «فوكس نيوز»، إنه يأمل في نجاح الجهود لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود «وبكل تأكيد عملية السلام لم تمت»، هذا في حين زعم جون بولتون «أن افتتاح السفارة في مدينة يريد الفلسطينيون أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية، سيعزز احتمالات السلام». وفي هذا الكلام استغباء للعالم الذي سبق أن ندد في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية 128 دولة من أصل 193، وبينها دول صديقة لواشنطن مثل بريطانيا وفرنسا، بقرار ترمب نقل السفارة، وهو ما اعتبرته نيكي هيلي يومها «إهانة لن ننساها»!
بالتأكيد لن يسمع ترمب بالطفلة الرضيعة ليلى الغندور، التي ماتت بالغاز الإسرائيلي، ولا بالطبيب معتصم النونو الذي ألقوا جثة شقيقه بين يديه؛ لكن الاحتفال في معناه الحقيقي والدائم لم يكن في القنصلية الأميركية في القدس المحتلة؛ بل على الحدود الشرقية لغزة، حيث ارتفع صوت الدم الصارخ مطالباً بحق لن يسمعه لا ترمب ولا نتنياهو؛ لكنه سيبقى، والدليل ليس أن الرُّضَّع يستشهدون لفلسطين؛ بل هو أن معظم الذين تساقطوا عند الحدود بالرصاص الإسرائيلي هم شباب بين 14 و30 سنة، أي أن أعمارهم لا تصل إلى نصف عمر النكبة، بما يعني أن الحق الفلسطيني لن يضيع؛ لأنه مُتوَارث بالدم، الذي له وحده صفة العَظمة، وليس للقتل المفعم بالعار والفظاعة!
GMT 14:15 2024 الأربعاء ,15 أيار / مايو
في ذكرى النكبة..”إسرائيل تلفظ أنفاسها”!GMT 12:08 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
مشعل الكويت وأملهاGMT 12:02 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
بقاء السوريين في لبنان... ومشروع الفتنةGMT 11:53 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
“النطنطة” بين الموالاة والمعارضة !GMT 11:48 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
نتنياهو و«حماس»... إدامة الصراع وتعميقه؟وزير الاستثمار المغربي يكشف عن استفادة 48 مشروعاً من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية
الرباط - المغرب اليوم
كشف كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن استفادة 48 مشروعا من المنحة الترابية المخصصة للاستثمارات في الأقاليم التي تعاني نقصا في التنمية. وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الش�...المزيدالمغربية سميرة سعيد تسّتعيد ذكريات طفولتها وشغف البدايات بفيديو نادر
الرباط - المغرب اليوم
فاجأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، جمهورها بمقطع فيديو نادر، ظهرت خلاله وهي طفلة تغني على المسرح مُنذ أكثر من 50 عاماً، أغنية "كيفاش تلاقينا".وقالت سميرة سعيد، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام: "كلّما أشاهد ن�...المزيدشركة ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستغرام
واشنطن - المغرب اليوم
تعتزم شركة "ميتا" إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي.وجاء في تقرير لصحيفة (فاينانشال تايمز) أن الشركة تعتزم، لكي تحافظ على قاعدة مست...المزيدوزير الثقافة المغربي يسّتعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث
الرباط - المغرب اليوم
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن من ضمن مرامي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي. وأبرز الوزير لدى تقديم مض...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©