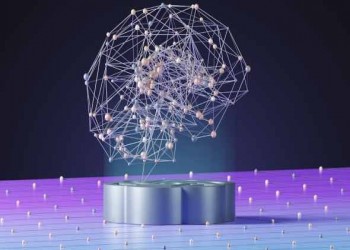الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
نحن والعالم (3/1)

رشيد نيني
بالتزامن مع تنازل القوى الغربية عن منطقة الشرقين الأدنى والأقصى وتقديمها على طبق من ذهب لإيران، التي ستتقاسم الهيمنة عليها مع إسرائيل، ومع ظهور بوادر الانقسام داخل المملكة العربية السعودية، وتحدث أكثر من جهة عن احتمال تنازل العاهل السعودي عن العرش لفائدة ابنه ووزير دفاعه، أحمد بن سلمان، هذا دون إغفال الأزمة المالية الحادة التي تعرفها الميزانية السعودية بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط الخام، ومع تعامل الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان بنوع من التساهل والليونة مع وضع طهران الجديد، يطرح سؤال في غاية الأهمية وهو: ماذا عن شمال إفريقيا عموما ومنطقة المغرب العربي خصوصا؟
في وقت تستهل منطقتنا سنة 2016 على وقع تحديات أمنية كبيرة، هناك معلومات موثوقة توضح بالملموس التهديدات الأمنية التي على المنطقة مواجهتها على المدى القريب، وهو ما تجسده حالة الإصرار شبه اليومي على خلق حالة من الفوضى سواء بسبب محاولات تمرير كميات كبيرة من العتاد الحربي والذخيرة والمتفجرات أو حتى المخدرات، دون إغفال محاولات ارتكاب اعتداءات إرهابية.
فمصر، على سبيل المثال، تقع بين نارين، في الشرق، تفرض «داعش» قانونها على شبه جزيرة سيناء، في حين يعجز الجيش المصري عن إعادة النظام إليها. أما في الغرب، فهناك الآلاف من الكيلومترات من الحدود مع ليبيا غير مراقبة، ما يجعل من مصر إحدى أكبر الدول عرضة للمخاطر.
وفي ليبيا، تسعى الميليشيات والمرتزقة والمجموعات الإرهابية المنضوية، إما تحت لواء «داعش» أو «القاعدة»، جاهدة إلى إعادة الانتشار والتحضير لمرحلة ما بعد اتفاق الصخيرات، لتجعل من هذا البلد المركزي، الذي يشكل صلة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوربا، قاعدة خلفية للإرهاب الدولي، وهي فرصة سانحة لهذه المجموعات للبقاء على الأرض بفضل إمساكها بأوراق استراتيجية رابحة تتمثل في أسلحة نظام القذافي البائد وفي مواقع استراتيجية تمكنها من السيطرة على النفط والغاز الطبيعي.
تونس، من جهتها، تتربص بها تهديدات جدية أبطالها التنظيمات الإرهابية، وهو ما يجعل البلد مفتوحا دون أي حسيب ولا رقيب، ولا أدل على ذلك من الاعتداءات الأخيرة التي خلفت عشرات القتلى من المدنيين الأجانب ومن أبناء الوطن وحتى من القوى الأمنية.
يبقى السؤال المطروح هو من هي الجهة التي تمول هذه الترسانة العسكرية القادمة من دول أجنبية أهمها ليبيا، وتلك التي تؤمّن طريق نقلها، وما هو الهدف من ورائها، إن لم يكن شيئا آخر غير إشعال الفتنة في كل من تونس والجزائر والتسبب في إزهاق المزيد من الأرواح؟
ولعله من الأهمية التعرف على هوية التنظيمات الاحترافية ومصادر تمويلها المضمونة والوفيرة، وحتى قدرة الشبكات على العودة إلى الحياة من جديد بعد محاربتها. وهو ما رأيناه رأي العين، في الأيام الأخيرة، مع اعتداءات باماكو في مالي وواغادوغو في بوركينافاسو، والتي قضى فيها عشرات المدنيين. وحتى السلطة المركزية، التي كانت قوية في ذلك الوقت، في الجزائر لم يعد بإمكانها القدرة على التحكم في عمليات التسرب هذه ولا حتى منعها على الأقل.
هذا دون الحديث عن كون الدبلوماسية الجزائرية معروفة بنشاطها الكبير داخل المحافل الدولية لإخفاء مشاكلها الحقيقية وتوجيه اهتمام الأوساط الدولية نحو وهم يطلق عليه جزافا الصحراء الغربية، وهو أمر لا يحدث حصرا داخل أروقة الأمم المتحدة أو حتى الاتحاد الإفريقي، وإنما أيضا داخل المؤسسات التابعة للاتحاد الأوربي.
وفي ما يخص الأمم المتحدة، تسعى الجزائر جاهدة لتقويض كل جهود المغرب للتوصل إلى حل عادل ودائم لمسألة الصحراء، أما في الاتحاد الإفريقي، فلا تتوانى في رد أي موقف مساند للمغرب، سيما ما يرتبط بمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط. وفي الاتحاد الأوربي، تحاول جاهدة عرقلة الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب لدى بروكسيل، وذلك من خلال السعي للحيلولة دون نجاح الاتفاقيات الموقعة في مجالات الفلاحة والصيد البحري، وما قرار المحكمة الأوربية إلا دليل على هذه التحركات الجزائرية المشبوهة.
وبما أن المال هو عصب الحرب، فالجزائر تعلم علم اليقين أن مداخيل البترول محدودة في الزمن وأنه من الأهمية استعجال بدء التفكير في تنويع مداخيلها. وحتى نوايا الجزائر السياسية لتهديد استقرار المغرب واضحة جلية ولا تتوانى في استنزاف كل الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض، غير أن الإشكال المطروح أمامها يتمثل في كونها تجر خلفها سنوات من التخلف في ما يخص التنمية البشرية مقارنة مع المغرب، سيما ما يهم البنيات التحتية الخاصة بالطرق والمطارات والموانئ والوسائل اللوجيستيكية والأسواق المالية والقواعد القانونية المنظمة.
وقد حقق المغرب في هذه المجالات المندرجة في ما يسمى الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، قفزة نوعية خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، غير أن الجزائر لا تفكر في ترك المغرب لحال سبيله وتسعى جاهدة لعرقلة كل مساعينا، والحرب في هذا الصدد ستكون سياسية واقتصادية وربما عسكرية حتى.
بداية ستحاول الجزائر العدول عن فكرة إنشاء أنبوب لنقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا والذي يمر عبر المغرب مقابل سومة سنوية مهمة، والاستعاضة عنها بتشييد أنبوب يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة ويعبر المتوسط، وهو المشروع الثاني من نوعه في هذا المجال.
وحتى على المستوى الجيو استراتيجي الإقليمي، تحاول الجزائر تطويقنا، حيث تجمعها بموريتانيا علاقات طيبة، فيما تعرف علاقات هاته الأخيرة بالرباط بعض الفتور. أما علاقات الجزائر بإسبانيا فهي جيدة وهو ما يختلف مع ما تعرفه علاقات هذه الأخيرة بالمغرب من تذبذب. كما لا يجب علينا أن ننسى الأزمة في دولة مالي، حيث كان المغرب سباقا إلى الاهتمام بها وسعى إلى إيجاد حل لها، غير أن الجزائر ارتكبت جريمة نكراء في هذه القضية، إذ جعلت منها قضية أمنها القومي.
وفي الملف الليبي، قامت الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية بكل ما في وسعها لعرقلة المسار السلمي الذي جرى في الصخيرات تحت رعاية مغربية.
وفي الأخير، وعلاقة بموضوع التحالف ضد الإرهاب تحت قيادة المملكة العربية السعودية، رفضت الجزائر الدخول كطرف فيه، متعللة بكونها تريد البقاء كطرف محايد، بل وصل بها الأمر إلى اعتبار العملية غير واضحة ومشكوكا فيها حتى، في إشارة واضحة إلى المغرب باعتباره غير مستقل ولا يقوم بشيء سوى بالتبعية العمياء.
لكن أحيانا تحدث الأشياء عكس المتوقع، ومع انخفاض ثمن برميل البترول لما دون الـ30 دولارا، وهو انخفاض بلغ عتبة 60 في المائة وهو على هذه الحال منذ سنتين، لم يعد بإمكان الجزائر الاستمرار في شراء السلم الاجتماعي ومضايقة المغرب، ما يجعل كل خططها في مهب الريح.
مكتب الصرف يفيد بارتفاع العجز التجاري بنسبة 6,5 % في المغرب
الرباط - المغرب اليوم
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نوفمبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية،...المزيدالمغربية سميرة سعيد تسّتعيد ذكريات طفولتها وشغف البدايات بفيديو نادر
الرباط - المغرب اليوم
فاجأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، جمهورها بمقطع فيديو نادر، ظهرت خلاله وهي طفلة تغني على المسرح مُنذ أكثر من 50 عاماً، أغنية "كيفاش تلاقينا".وقالت سميرة سعيد، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام: "كلّما أشاهد ن�...المزيدشركة ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستغرام
واشنطن - المغرب اليوم
تعتزم شركة "ميتا" إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي.وجاء في تقرير لصحيفة (فاينانشال تايمز) أن الشركة تعتزم، لكي تحافظ على قاعدة مست...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - المغرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©