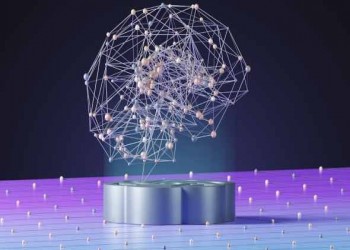الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الـراس اللـي مـا يدور كـدية

بقلم : نور الدين مفتاح
ترك الملك محمد السادس البلاد وهي تتماوج على إيقاع مشاورات تشكيل الحكومة، بعدما عين السيد عبد الإله ابن كيران رئيسا للجهاز التنفيذي لولاية ثانية، وشد الرحال إلى القرن الإفريقي ليبدأ واحدة من الجولات غير المسبوقة في تاريخ المملكة نظرا لوعورتها السياسية وأهميتها الاستراتيجية.
إن نجاح المملكة في الاختراق الإفريقي خلال العقد الماضي ماثل أمام العيان، ولكن نقطة ضعفها كانت تتمثل في ارتهانها لمحور أصدقاء المغرب، وخصوصا في إفريقيا الغربية، وظلت العقيدة الديبلوماسية المغربية منذ مغادرة منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 هي أن من يعترف أو يتناغم مع البوليساريو فهو معادٍ للمملكة المغربية، وأصبحت أبواب الدول المتعاملة بشكل أو بآخر مع «الجمهورية الصحراوية» مشرعة أمام الجزائر، وكل هذا كانت له جذور في التعامل مع الأصل، حيث ترسخ في ذهن الرأي العام المغربي أن كل من يوجدون في تندوف فهم مرتزقة ووهم وما إلى ذلك مما ظل يتناقض مع المسلسل الأممي الذي ينخرط فيه المغرب لتسوية قضيّة الصحراء، والذي يعتبر فيه الطرف الآخر هو البوليساريو الذي فاوضته الرباط سريا وعلانية في عشرات المرات وبعشرات العواصم العالمية.
والواقع أن المتغيرات العنيدة للواقع تفرض تغيير القناعات، والمثل المغربي البليغ يقول "الراس اللي ما كيدور كدية"، ورأينا كيف أن نشطاء من البوليساريو في الداخل أصبحوا ينشطون مكشوفي الوجوه، وأن صحراويين وحدويين أصبحوا يتحدثون عن الإخوان في تندوف، ورسميا تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي، وترجمته الجافة هي التنازل عن جزء من «السيادة» المركزية المغربية لصالح سكان الصحراء أجمعين.
إن خيبة أمل العهد الجديد في حجم التجاوب مع هذا التنازل المعتبر من طرف الرباط دفعت المغرب أحيانا إلى نهج سياسة رد فعل هجوميّة حتى على قوى عظمى، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لم يثنه عن مواصلة مشروع مؤسس استراتيجي قد يكون هو مشروع حكم محمد السادس، ألا وهو التأسيس للمغرب كلاعب كبير في القارة الإفريقية، واختيار ركائز مغايرة لركائز استقطاب الخصوم التقليدية، وهي البترول أو الغاز الذي كان يسمن الأنظمة ويبذر بذور عدم الاستقرار، حيث اختار المغرب الاستثمار وتقاسم الخبرة والدفع بالنمو والنهوض الاقتصادي ارتكازا على الفلاحة والخدمات والإعمار وغير ذلك مما يجعل الشراكات مفيدة للأنظمة وللشعوب على حد سواء، وزدنا على هذا تثمين البعد الروحي في هذه العلاقات الديبلوماسية الجديدة والبعد الثقافي، بتصحيح مفاهيم الانتماء الإفريقي، ولعل العودة لجزء من خطاب الملك لـ 20 غشت الماضي ضرورية لفهم هذه الجولة المثيرة لمحمد السادس في دول شرق إفريقيا:
«إن إفريقيا بالنسبة للمغرب أكثر من انتماء جغرافي وارتباط تاريخي، فهي مشاعر صادقة من المحبة والتقدير، وروابط إنسانية وروحية عميقة وعلاقات تعاون مثمر، وتضامن ملموس، إنها الامتداد الطبيعي والعمق الاستراتيجي للمغرب». ويضيف الملك في رسم دقيق لحدود العلاقات المتوخاة مع الدول الإفريقية: "المغرب يعطي دائما لشعوب قارته ولا ينتظر أن يأخذ منها، والتزامه من أجل قضاياها وانشغالاتها لم يكن يوما من أجل استغلال خيراتها ومواردها الطبيعية، خلافا لما يسمى بالاستعمار الجديد… فنحن لا نعتبر إفريقيا سوقا لبيع وترويج المنتجات المغربية، أو مجالا للربح السريع، وإنما هي فضاء للعمل المشترك من أجل تنمية المنطقة وخدمة المواطن الإفريقي".
وقد جاء هذا الكلام عقب تذكير الملك في الخطاب ذاته بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي الذي حدد له إطار الالتزام بمواصلة العمل على نصرة قضايا الشعوب الإفريقية.
وإذا كانت الخطب الرسمية عموما تتميز بلغة المجاملات والعموميات، فإن هذا الخطاب كان مدروسا بعناية وهو يتوجه لدول وشعوب إفريقية متوجسة من تغيير كبير أقدم عليه بلد إفريقي كبير ظل بعيدا عن اتحاد إفريقيا وقرر فجأة العودة، مما سيولد بالضرورة أسئلة مشروعة كان لابد لها في البداية من رسائل تبعث إلى العناوين المضبوطة، وبالتالي، تم شرح البعد الحقيقي للتحرك المغربي في إفريقيا واللعب على الوتر الحساس المتعلق بالاستعمار الجديد وتهييء التربة الخصبة لاقتحام قلاع خصومنا، وهذا ما يجري اليوم والملك يستقبل بحفاوة في أوغندا وتنزانيا وإيثيوبيا، وكلها دول قريبة من أطروحة الانفصال ولم يسبق لها أن اقتربت من دولة لم تسمع عنها إلا أنها دولة توسعية تهضم حق شعب طريد في تقرير مصيره بالصحراء الغربية!
إنه لمن الإنصاف الاعتراف بأن قضية الوحدة الترابية للمملكة هي بيت القصيد في هذا البناء الإفريقي في صرح الديبلوماسية المغربية، إلا أن هذا الهدف المشروع والحيوي لاستمرار واستقرار المملكة جرّ وراءه من حيث يدري أو لا يدري نموذجا كاملا من التعاون الجديد جنوب جنوب ناجحا ومثمرا ومجسدا بصدق لمعادلة "رابح رابح"، وهذا بعيد بعد الأرض عن المريخ عن استراتيجية الراحل غير المأسوف عليه معمر القذافي ملك ملوك إفريقيا، الذي استعمل جنون العظمة ممولة بالغاز والدولار لتدويخ القارة، وعن الاستراتيجية الجزائرية التي اعتمدت على البترودولار المخضب بخطاب الثورة واصطفافات الحرب الباردة.
إننا اليوم قريبون من منافسين جديين في القارة، وعلى رأسهم تركيا والصين والهند، ولكن قوة المغرب في انبثاقه من التربة الإفريقية وامتلاكه لمشروعية التأسيس في القارة وقدرته على التأثير كعلامة مسجلة كنّا معطلين لها إراديا إلى أن قررنا العودة إلى الاتحاد الإفريقي.
والعبد لله ليس من الذين يعتقدون أن الخروج من منظمة الوحدة الإفريقية كان خطأ، ولا أن أمر العودة للمنتظم الإفريقي كان فيه تأخر كبير، فالتحليل لا يستقيم إلا إذا استحضر السياق، والمواقف بسياقاتها، والأمور لا تؤخذ إلا ناضجة كالثمار، ولكي تنضج الثمرة، على السياسي المحنك الانتظار على ألا يخطئ الموعد، فهذه الثمرة عندما تنضج ولا تقطف تسقط تلقائيا، إنها سنة الطبيعة، ومنها طبيعة الإنسان الذي تجسد السياسة أعقد مظاهر تدبير علاقاته داخليا وخارجيا.
إن ما يجري هناك في منبع النيل العظيم مع جمهرة من السياسيين ورجال الأعمال والمستشارين، يتقدمهم ملك البلاد، لهو شديد الارتباط بما يجري بحي الليمون بالرباط، فحكومة جدية وقوية بعيدة عن اللعب والمناورات السياسوية لهي ضمانة لتقوية حظوظ نجاح هدفنا البعيد في الدخول منتصرين للاتحاد الإفريقي وتحويل اتجاه القارة السمراء إلى صفنا، صف الحق التاريخي في وحدتنا الترابية. لقد انتصرت العدالة والتنمية، واحترمت المنهجية الديموقراطية، وعلينا أن نطوي الصفحة لينكب من حملوا المسؤولية على ملفاتهم لتحويل المغرب إلى أسد إفريقي، ليس في الكرة ولكن في نموذجه التنموي، وما عدا ذلك من حواشٍ وخزعبلات فهو جريمة في حق الوطن وإن كان بحسن نيّة.
GMT 13:17 2019 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر
ثلث المغاربة لا يفتخرون بمغربيتهم..لماذا؟GMT 05:26 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
تأملات على هامش ستينية الاتحاد الاشتراكيGMT 03:32 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر
تأملات على هامش ستينية الاتحاد الاشتراكيGMT 00:36 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
في هجاء الريسونيGMT 04:55 2019 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر
قراءة في طلاق ملكيوزير الاستثمار المغربي يكشف عن استفادة 48 مشروعاً من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية
الرباط - المغرب اليوم
كشف كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن استفادة 48 مشروعا من المنحة الترابية المخصصة للاستثمارات في الأقاليم التي تعاني نقصا في التنمية. وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الش�...المزيدالمغربية سميرة سعيد تسّتعيد ذكريات طفولتها وشغف البدايات بفيديو نادر
الرباط - المغرب اليوم
فاجأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، جمهورها بمقطع فيديو نادر، ظهرت خلاله وهي طفلة تغني على المسرح مُنذ أكثر من 50 عاماً، أغنية "كيفاش تلاقينا".وقالت سميرة سعيد، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام: "كلّما أشاهد ن�...المزيدشركة ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستغرام
واشنطن - المغرب اليوم
تعتزم شركة "ميتا" إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي.وجاء في تقرير لصحيفة (فاينانشال تايمز) أن الشركة تعتزم، لكي تحافظ على قاعدة مست...المزيدوزير الثقافة المغربي يسّتعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث
الرباط - المغرب اليوم
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن من ضمن مرامي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي. وأبرز الوزير لدى تقديم مض...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©