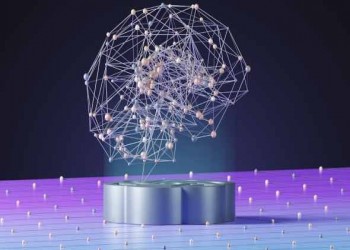الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
20 فبـرايـر.. أو «الاسـتشـعـار عـن بَـعـد..»!

بقلم : عبد الحميد الجماهري
في الذكرى السادسة لـ20 فبراير، تبدو وكأنها خرجت من جدلية الفعل الخلاق والنشيط، القادر على فتح شارع جديد في السياسة، الفعل الواعي، المرتبط بتحولات البناء الديموقراطي وتدارك التأخر في الهندسة المؤسساتية للديموقراطية ودخلت منطقة التأويل، أو «الاستشعار عن بَعد..»، أي استدراجها كأفق ملتبس حامل للغضب والاحتجاج، وقابل للعودة، بسقف أعلى، وهي بذلك تفقد من تاريخيتها وتنزلق إلى سحر ما، وغموض انتشائي، يسعى إلى رفعها كسيف قابل للخروج من الزمن الذي مضى لتصحيح الزمن الحالي أو القادم..
التاريخ، منذ أن نبه كارل ماركس إلى ما في تمرين التكرار من احتمالات الملهاة، لا يميل إلى إعادة نفسه.. فهو يعرف بأن السخرية تقبع في ظلاله..
وتقبع في اي استنساخ ممكن!
كما أن في كل حنين، شيئا ما من المسكوت عنه قد يغفله التحليل السياسي المباشر، لكن لا تخطئه جدلية المحلل للخطاب أو المقتفي لتحولات الميدان.. وبذلك يمكن اعتبار هذا الاحتفاء المتنكر بذكرى 20 فبراير شبيها بمحاولة محاكاة لحظة سياسية فريدة، باستعادتها، بعد نزع لحظيتها ودقتها الزمنية..
حقيقة الوضع، بعد أن ننزع عن تلك اللحظة كل سحرd?senchantement هي أن الخروج العام كشف أمرين اثنين:
1- القدرة الإصلاحية لدى فئات واسعة من المغاربة، عبر امتداد أفقي »يخترق الأحزاب والنقابات والمجتمع، ويترك آثاره على تربة وبنية الأحزاب الوطنية«..
2- القدرة التفاعلية، في هذا الأفق الإصلاحي من لدن المؤسسة الملكية، أي قطب النظام بدون تغيير جذري في التاريخ العام أو الخاص لها.
وما بينهما، طبعا، نص دستوري يسعى إلى ضبط طبيعة الدولة على أساس التوازن الفطن، والتفاؤل التاريخي الذي طبع المرحلة..
ولقد كان عبد الله العروي، صريحا وحادا في جدليته، عندما قال بأن النص الدستوري لسنة 2011 كان أهم من الحركية نفسها، بناء على تاريخانية الحدث..
وبناء على أثره..
ولهذا نجد أننا لا نناقش السياسة وتطورات السياسة بناء على شعارات 20 فبراير
ولا على أساس ديالكتيك العفوية والتنظيم..
ولا على قاعدة ما تبقى وما ضاع من الخروج الجليل لشعب يريد التغيير…
بقدر ما يجب أن ينجح النقاش العمومي، والسلوك السياسي المتفرع عنه، في تطوير النصوص بالممارسة، واحترام حمولاتها التقدمية، والاحتياط الديموقراطي الذي اكتسبته بقوة التقاء إرادتين فاعلتين في صيانة المكتسب الديمقراطي:إرادة التغيير الشعبي وإرادة الاستباق الملكي..
لقد كتب العبد الضعيف لرحمة ربه في يونيو من 2011، ولم تمض سوى أربعة أشهر أو زد عليها قليلا، أن »موجة العمق الفبرايرية، إذا لم تكن انطلاقة التاريخ، فهي أيضا لم تكن موتا للسياسة أو تراكما حصريا وبيانيا لما تم قبلها. فقد استطاعت الحركة فعلا أن ترفع إلى الواجهة مطالب دستورية وسياسية عالية السقف، بدون أن تدعو إلى إسقاط النظام أو ما يشبه ذلك. واستطاعت الحركة في عنفوانها أن تحدد السقف الذي أقرته كل مكوناتها، ودفعت الأطراف القصوى من هذه المكونات إلى التزام الدعوة إلى تغيير قوي من تحت سقف وجود النظام…«…أولا.
ثانيا: استطاعت حركة 20 فبراير إخراج مطالب معينة، كانت إلى حد الساعة تتداول بهمس وسط الأوساط المحدودة والضيقة والنخبوية. والحركة وإن كانت لم تكنس الفضاء العمومي أو الشارع العام، فقد وسعت من قطر الدائرة، بدخول فضاءات احتجاجية إلى الممارسة العامة والعلنية.
ثالثا : نبهت إلى أن المعالجة المعتمدة على الاختيار التقنوقراطي والتسييس التدبيري للمجتمع المدني، قد وصلت إلى حالتها القصوى وعطائها المفترض. وأن الأساس الذي اعتمدت عليه مقاربة من هذا النوع، والقاضي بأن السياسة والسياسيين لا يستحقون الثقة والاحترام، وأنهم غير قادرين على تقديم الأجوبة والإصلاحات، هذا الأساس لم يعد قادرا على الإقناع. وأن النتيجة »كانت هي نزع الطابع السياسي عن القضايا السياسية أو الطابع المؤسساتي عن السياسة عموما، ووضع السياسة في مواضع لا سياسية…« .
لهذا عندما نريد أن نخلص إلى خلاصات، فإن ما يتبادر إلى ذهننا هو:
- ضرورة حصر النقاش في المحتمل التقدمي في النصوص والسلوكات المتفرعة عن هذه اللحظة.
- توسيع دائرة النقاش العمومي بما يجعل النقاش السياسي لا يسقط في أية نزعة سحرية أو تراجعية، تعيد عقارب الزمن إلى ساعة الاحتقان..
- وصول أطراف سياسية إلى منطقة «اللافعل»، وعودتها إلى منطق الاحتجاج والمرتبط بالتشكي، بدون مسارات واضحة كما حدث في فبراير إياه، بالنظر إلى العجز عن الجواب عن احتمالات الفعل الإصلاحي الذي قدمته المرحلة وقتها،
- عودة أطراف أخرى إلى منطق التضاد الأقصى، أو »»التحاد»، كما لو أن المرحلة لم تكن خصبة، وإلى العجز عن تطوير المتن الدستوري ومساعدته على… الواقع!
إن 20 فبراير ليست للنسيان، ولا للعفوية المقدسة، بل هي لحظة زمن للتغيير وبناء المستقبل .. والتذكير بالاحتياطي الديموقراطي الدائم عند الاتفاق على جوهر الاشياء!
المصدر : جريدة الاتحاد الإشتراكي
GMT 12:43 2019 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
حتى لا نتقدم نحو المستقبل بلا ذاكرة ولا جذور! .. الفرز السياسي على قاعدة الإرادة في الإصلاحGMT 12:39 2019 الإثنين ,06 أيار / مايو
مفارقة الجزائر بين واقع متحرك ومسؤولية ثابتةGMT 03:42 2017 الإثنين ,10 تموز / يوليو
عندما يثق محمد الخامس في الفقراء والشهداء... ولا يخيبGMT 06:44 2017 الأربعاء ,01 آذار/ مارس
انسحاب الكركرات في المعركة والسلام المسلح..GMT 06:44 2017 الثلاثاء ,28 شباط / فبراير
استراتيجية التوتر: رهان قوة جديد حول الصحراء..وزير الاستثمار المغربي يكشف عن استفادة 48 مشروعاً من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية
الرباط - المغرب اليوم
كشف كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن استفادة 48 مشروعا من المنحة الترابية المخصصة للاستثمارات في الأقاليم التي تعاني نقصا في التنمية. وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الش�...المزيدالمغربية سميرة سعيد تسّتعيد ذكريات طفولتها وشغف البدايات بفيديو نادر
الرباط - المغرب اليوم
فاجأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، جمهورها بمقطع فيديو نادر، ظهرت خلاله وهي طفلة تغني على المسرح مُنذ أكثر من 50 عاماً، أغنية "كيفاش تلاقينا".وقالت سميرة سعيد، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام: "كلّما أشاهد ن�...المزيدشركة ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستغرام
واشنطن - المغرب اليوم
تعتزم شركة "ميتا" إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي.وجاء في تقرير لصحيفة (فاينانشال تايمز) أن الشركة تعتزم، لكي تحافظ على قاعدة مست...المزيدوزير الثقافة المغربي يسّتعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث
الرباط - المغرب اليوم
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن من ضمن مرامي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي. وأبرز الوزير لدى تقديم مض...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©