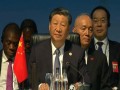الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
“النسر وعيون المدينة”

جمال بودومة
في مستهل التسعينيات، كنا ندرس في “المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي” وسط الرباط، قبل أن ينتقل إلى “مدينة العرفان”، كانت الأقسام الدراسية موزعة بين الطابق الرابع من مسرح محمد الخامس وقصبة الاوداية، والسكن الوحيد المتاح للطلاب هو “الحي الجامعي مولاي اسماعيل” في حي المحيط، وهو في الأصل ثكنة عسكرية، اعتقل فيها انقلابيو 71 قبل أن يتم إعدامهم. نحن لم ننقلب على أحد، ومع ذلك وجدنا أنفسنا في الثكنة. الحي يتوفر على أجنحة للأولاد واُخرى للبنات، كل جناح مقسم إلى “ضورتوارات” بأسرة متراكبة. كأنك انخرطت في الجندية. كانت الأحياء الجامعية في “مدينة العرفان” تبدو لنا مثل إقامات بخمسة نجوم. كنا نحسد سكان “السويسي 1″ و”السويسي 2″ و”كلية علوم التربية” وغيرها من الإقامات التي توفر للطلاب غرفا حقيقية، وتتوفر على مطاعم محترمة، خصوصا أن “مولاي اسماعيل” كان يقدم وجبات حقيرة، متخمة “بالصودا”، لدرجة يصعب معها أن تفرق بين العدس واللحم والبطاطا والحريرة، كلها بالمذاق نفسه. “مدينة العرفان” وإقاماتها الجامعية بعيدة وليست في المتناول، حتى السكن في “مولاي اسماعيل” لم يكن مضمونا، الإدارة لا تقبل إلا عددا محدودا من طلاب المعهد. من لم يحالفهم الحظ يفتشون عن غرفة مهترئة في المدينة العتيقة، في “الجزا” أو “بوقرون”. لا أعرف كيف اكتشفنا أن هناك فندقا يقترح غرفا للإيجار الشهري بأثمان معقولة، غير بعيد عن حجرات الدرس. اسمه فندق “الاوداية”، لكن الجميع يسميه “فندق شارلو”. “شارلو” كان لقب موظف الاستقبالات، الذي لا يمكن أن تفهم ما يقوله، بسبب إعاقة تشبه الخرس، أي شيء تطلبه منه يحرك راْسه ذات اليمين وذات اليسار وهو يردد: “لآ لا لا”… بمجرد ما تضع قطعة نقدية في يده تتحول الـ”لا” إلى “نعم”!
سكنا لسنوات في ذلك النزل المجاور للأموات والمهمشين. فندق بلا نجوم بجوار مقبرة وسجن وكوميسارية وكثير من ذوي السحنات المشبوهة. على بعد خطوات من المحيط.
هناك، في فندق “شارلو” التقيت بالمسرحي العراقي بدري حسون فريد، الذي غادر الحياة الأسبوع الماضي في أربيل.
كان شخصا مهيبا، بقبعته ومعطفه واعتداده بنفسه. كانت غرفته جنب غرفتي، وكان يفضل أن يترك الباب مفتوحا. كلما مررت ألمحه يكتب أو يتدرب على أحد الأدوار، بصوته الجهوري الواثق. كنت أتساءل من أين يأتي بكل هذه الحيوية؟ رجل تجاوز السبعين لا يتوقف عن العمل. من حين لآخر ينزل إلى البهو، حيث يجلس لوحده في زاوية يدخن الغليون ويحتسي القهوة ويتأمل سحائب الدخان. لم أقتنع يوما أن بدري حسون فريد شخصية حقيقية. كان يبدو لي مثل هارب من إحدى روايات جبرا إبراهيم جبرا أو حنا مينا. الحقيقة أنه كان هاربا من بلد مدمر يستعد للأسوأ. كان صدام حسين قد أقدم على مغامرته المجنونة بغزو الكويت، ودمرت قوات التحالف جيشه، ليدخل العراق سنوات الحصار الطويلة. لم يكن الناس يجدون الطعام والدواء، لذلك كان الجميع يفتش عن بلدان أقل قسوة. لست متأكدا إذا ما كان الراحل اختار البلد المناسب، لكن الأكيد أنه لم يكن مرتاحا ماديا، ولم يستطع أن يعثر على شغل يناسب كفاءته ويضمن له العيش الكريم. الرجل من جيل الرواد في المسرح العراقي، تخرج من قسم الفنون المسرحية في معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 1955، وكان الأول على دفعته، ثم أكمل دراساته العليا في شيكاغو قبل أن يعود إلى بلاده مدرسا ومخرجا وممثلا. عندما وصل إلى المغرب كان يجر خلفه مسارا طويلا على الخشبة وبين فصول التدريس، لكننا لم نحسن استقباله. كان يريد الاستقرار في الرباط، وظل يفتش عن وضع قار، ولكنه لم يعثر سوى على منصب أستاذ بالقطعة في المعهد العالي للمسرح، فضلا عن أدوار في بعض المسلسلات. لم نمحه ما يستحق، ما عدا “حب الطلبة والفنانين”، كما كتب الأستاذ أحمد مسعاية في نعيه، هو الذي كان وقتها مديرا للمعهد العالي للمسرح وصنع المستحيل كي يحسن وضعه دون جدوى.
كان في صوته شجن دفين. مازلت أتذكر طاقته المدهشة في مسرحية “المصطبة” التي أداها لوحده على الخشبة بإخراج تلميذه جواد الأسدي. ذات يوم في بهو فندق شارلو حكى لي بكثير من النوستالجيا عن مسلسل كان يعرضه التلفزيون العراقي في مستهل الثمانينيّات، وعرف نجاحا كبيرا في كل دول الخليج. اليوم عرفت أنه بالنسبة إلى كثير مِن العراقيين، الذي مات الأسبوع الماضي هو “إسماعيل الجلبي”، الذي صنع سعادتهم في مسلسل “النسر وعيون المدينة”، أيّام كان الفن فنا والعراق عراقا
GMT 14:36 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
انتقام... وثأر!GMT 14:29 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
المعرفة التي قتلت لقمان سليمGMT 14:25 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
هل نسي الغرب تماماً استراتيجية «تصدير الثورة»؟GMT 14:20 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
4 مليارات ثمن 12 بيضةGMT 13:58 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
بايدن والسعوديةوزارة الإقتصاد والمالية المغربية تعلن إرتفاع المداخيل الضريبة بنسبة 12,5 في المائة
الرباط - المغرب اليوم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أ�...المزيدرافائيل نادال يختتم مشواره ويلعب مباراته الأخيرة في كأس ديفيز 2024
لندن - المغرب اليوم
يشارك لاعب التنس الإسباني الشهير " بطولة رافائيل نادال " في التنس الأخيرة في مسيرته الرائعة هذا الأسبوع، حيث سيمثل بلاده في كأس ديفيز 2024. يعتبر الإسباني البالغ من العمر 38 عاما، والذي يحتل المركز الثاني بعد " ...المزيدميركل تحذّر و تعبّر عن قلقها من سيطرة ماسك على 60% من الأقمار الصناعية
برلين - روان محمود
بعد كشفها عن تفاصيل لقاءاتها السابقة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال مقتطفات من مذكراتها التي ستصدر الأسبوع المقبل، أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن قلقها على النظام الديمقراطي مع ...المزيدالحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الذي قدمه وزير الشباب والثقافة
الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح بلاغ للوزا...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©