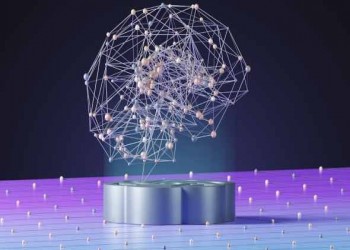الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
طاجين أبريل احترق أو يكاد

بقلم - توفيق بو عشرين
طاجين أبريل احترق أو يكاد، هذا ما كشفته خرجتان إعلاميتان؛ الأولى لعبد الإله بنكيران، نهاية الأسبوع الماضي، وما أعقبها من ردود فعل… وفيها قال زعيم الإسلاميين إنه ‘‘إذا كان ضروريا أن نخرج من هذه الحكومة، فلنخرج منها، لأن الحزب لن يغير جلده، سواء في عهد العثماني أو بنكيران’’، والخرجة الثانية كانت لعزيز أخنوش، في باريس هذه المرة، حيث أعاد القول إنه يتوفر على رؤية جديدة لإدارة ثلاثة قطاعات مهمة هي جوهر الأزمة الحالية، وهذه القطاعات هي التعليم والصحة والتشغيل. هذا هو برنامج «حكومة أخنوش»، التي بدأ الملياردير من الآن ترويجها بديلا لحكومة العثماني، وإلا لماذا لم يسلم أخنوش رئيسهَ في الحكومة هذه الرؤية «الخلاصية»؟ ولماذا يعرضها في التجمعات الانتخابية عوض تقديمها في المجلس الحكومي، مادام زعيم الحمائم مشاركا في الحكومة الحالية، ويدير أكثر القطاعات أهمية في الفريق الوزاري. لم يبق إلا معنى واحد لهذه الإشارات، وهو أن أخنوش بدأ من الآن حملته الانتخابية، وهي، في غالب الظن، لن تنتظر سنة 2021 حتى يكمل الطبيب النفسي مهمته، بل ستكون قبل ذلك بعد أن يجري إنهاء الحفل قبل الأوان، وإلا ما معنى أن يقول أخنوش ويعيد إن حزبه يمتلك الحلول لثلاث أزمات كبرى يعانيها البلد، في حين أنه وزير في الحكومة، ومن واجبه أن يقدم لها أي مقترح أو برنامج أو حل لأزماتها، لا أن يزايد عليها.
طاجين أبريل هو الاسم الحركي للطريقة التي تشكلت بها حكومة العثماني من ستة أحزاب، أغلبها تعرضت لعقاب الناخب، فوجدها الشعب أمامه تحكم.. طاجين أبريل يعني تشكيل حكومة دون سند شعبي ولا حزبي، وتوزيع المقاعد فيها على طريقة «يدي ويد القابلة». طاجين أبريل هو عنوان لإقفال القوس الذي فتح في 2011 بأقل كلفة، وعلى يد المصباح الذي ركب فوق ظهر الربيع المغربي. طاجين أبريل يعني دق مسمار الفرقة وسط حزب ظل بيته من حديد وسقفه من زجاج، حتى وقع الزلزال الذي جعل الحزب حزبين، والقيادة قيادتين، والرؤية رؤيتين.
هذا هو سطح المشهد السياسي الحالي، أما عمقه فأسوأ مما يظن أكبر المتشائمين، حيث لم يعد الرأي العام يتابع سوى أخبار الطقس والكرة وإعلان فوز طفل في برنامج مسابقات غنائية، والباقي لا يلتفت إليه لأنه لم يعد يثق في نخبه السياسية ولا في مؤسساته الدستورية.
تراجع الثقة في الدولة، والكفر بالسياسة يطرحان أسئلة صعبة، سواء على الفاعلين السياسيين أو على الذين يجعلون من السياسة موضوعا للتفكير والتنظير.
الثقة تبنى وتهدم، تبنى الثقة بمطابقة القولِ الفعلَ، وارتكاز الحكم على شرعية تتجدد، ووعود تتحقق، ومصلحة عامة توجه سلوك النخبة في بيت الحكم، بناء على قاعدتي المساواة بين جميع المواطنين، فقراء وأغنياء، أقوياء وضعفاء، والحرية للجميع في الحياة الخاصة والعامة في الحدود التي لا تمس حرية الآخرين.
وتهدم الثقة بين الحاكم والمحكوم بسبب تآكل شرعية الإنجاز، ومسلسل الإحباطات، ونتائج المناورات السياسوية، وبرنامج «سوف وسوف وسوف»… وبسبب وعود لا تتحقق، وسياسات لا تؤتي أكلها، ومؤسسات لا تشتغل، وتواصل لا يبعث الحرارة في سلك العلاقة بين الدولة والمجتمع.
الثقة اليوم بين الحاكم والمحكوم مثل قطعة ثلج تحت أشعة الشمس، كل ساعة يذوب منها جزء ولا يعوض بأجزاء أخرى، وهذا يقود إلى القطيعة، والقطيعة تؤدي إلى اعتماد أساليب أخرى للحكم غير الرضا، أي الإكراه والعنف المادي والرمزي والإقصاء، وجعل جهاز الدولة ضد الشعب وليس في خدمته.
من نتائج فقدان الثقة في السياسة اتساع حزب «الكنبة»، أو ما يمكن تسميته منسيو التمثيل الانتخابي les oubliés de représentation، أي أولئك الذين لم يجدوا لأنفسهم مكانة ولا رغبة في صندوق الاقتراع، ولا في العروض الانتخابية للأحزاب، ولا في اللعبة الديمقراطية المعطوبة، التي عوض أن تدمج، تقصي، وعوض أن تفتح أبواب المشاركة لأوسع قطاع، تغلق العملية السياسية على نخبة صغيرة تأكل ذاتها، وتنعزل عن القاعدة يوما بعد آخر، حتى يفاجأ الجميع بانتفاضة أو ثورة أو انقلاب… وكل هذه الأنماط من ردود الفعل تنبت في الفراغ السياسي الذي يفتح الدول والمجتمعات على المجهول… هذا ليس سيناريو خياليا أو مفترضا، لقد عاش بلدنا هذا الكابوس فعلا، ولولا ألطاف الله لكنا في مكان آخر تماما، فبعد أشهر من خروج انتفاضة الدار البيضاء في 23 مارس 1965، والتي واجهها أوفقير بالحديد والنار، سيخرج الحسن الثاني في يونيو من السنة نفسها في خطاب لإعلان حالة الاستثناء بمبررين اثنين؛ استحالة تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستحالة تشكيل أغلبية منسجمة. ماذا جاء بعد هذا؟ اغتيال بنبركة، والإعلان دستور 70 الذي جاء ليدستر حالة الاستثناء، ويشكل تراجعا مخيفا حتى عن دستور 62، ثم حدث الانقلاب الأول في 1971، والثاني في 72، وقبلهما دخل آلاف الاتحاديين إلى السجن، وجرى تجفيف ينابيع السياسة، ولم ينقذ البلد سوى المسيرة الخضراء سنة 1975، وإعادة فتح ملف استكمال الوحدة الترابية الذي نسج توافقا جديدا بين الدولة والأحزاب، وأعطى مشروعية الملك الراحل شحنة لإعادة إدارة البلد، والبحث عن توافق مع أحزاب الحركة الوطنية.
GMT 14:15 2024 الأربعاء ,15 أيار / مايو
في ذكرى النكبة..”إسرائيل تلفظ أنفاسها”!GMT 12:08 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
مشعل الكويت وأملهاGMT 12:02 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
بقاء السوريين في لبنان... ومشروع الفتنةGMT 11:53 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
“النطنطة” بين الموالاة والمعارضة !GMT 11:48 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
نتنياهو و«حماس»... إدامة الصراع وتعميقه؟وزير الاستثمار المغربي يكشف عن استفادة 48 مشروعاً من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية
الرباط - المغرب اليوم
كشف كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن استفادة 48 مشروعا من المنحة الترابية المخصصة للاستثمارات في الأقاليم التي تعاني نقصا في التنمية. وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الش�...المزيدالمغربية سميرة سعيد تسّتعيد ذكريات طفولتها وشغف البدايات بفيديو نادر
الرباط - المغرب اليوم
فاجأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، جمهورها بمقطع فيديو نادر، ظهرت خلاله وهي طفلة تغني على المسرح مُنذ أكثر من 50 عاماً، أغنية "كيفاش تلاقينا".وقالت سميرة سعيد، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام: "كلّما أشاهد ن�...المزيدشركة ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستغرام
واشنطن - المغرب اليوم
تعتزم شركة "ميتا" إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي.وجاء في تقرير لصحيفة (فاينانشال تايمز) أن الشركة تعتزم، لكي تحافظ على قاعدة مست...المزيدوزير الثقافة المغربي يسّتعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث
الرباط - المغرب اليوم
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن من ضمن مرامي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي. وأبرز الوزير لدى تقديم مض...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©